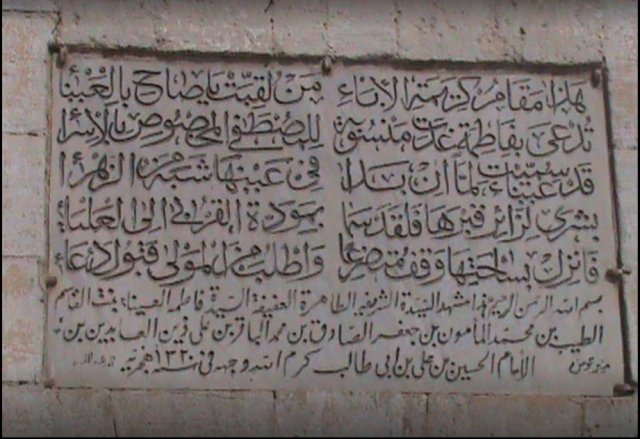رعاية الله لمن وَجَّهُوا هِمَمَهُم إليه(*) ([1])
ومثل مقامات اليقين ونور اليقين، الجامع لها كالأسوار المحيطة بالبلدة وقلاعها؛ فالأسوار هي الأنوار، وقلاعها هي مقامات اليقين التي هي دائرة بمدينة القلب، فمن أحاط بقلبه سور يقينه، وصحح مقاماته التي هي أسوار الأنوار كالقلاع -فليس للشيطان إليه سبيل، ولا له في داره مقيل.
ألم تسمع قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: 42]؛ أي: لأنهم قد صححوا العبودية لي، فلا هم لحكمي منازعون([2])، ولا في تدبيري متعرضون، بل عَلَيَّ متوكلون وإِلَيَّ مستسلمون؛ فلذلك قام لهم الحق سبحانه بالرعاية والنصر والحماية، ووجهوا هممهم إليه، فكفاهم مَنْ دُوْنَهُ.
قيل لبعض العارفين كيف مجاهدتك للشيطان؟ قال: وما الشيطان؟ نحن قوم تصرفنا إلى الله تعالى، فكفانا من دونه، وسمعت شيخنا أبا العباس -رحمه الله تعالى- يقول: «لما قال الحق تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: 6]؛ فقوم فهموا من هذا الخطاب أنَّ الله طالبهم بعداوة الشيطان، فصرفوا هممهم إلى عدواته، فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب، وقوم فهموا من ذلك: «إنَّ الشيطان لكم عدو»؛ أي: وأنا لكم حبيب، فاشتغلوا بمحبة الله، فكفاهم من دونه، ثم ذكر الحكاية المتقدمة.
فإن استعاذوا من الشيطان فلأجل أنَّ الله تعالى أمرهم بذلك، لا أنهم يشهدون أن لغير الله من الحكم شيئًا معه، وكيف يشهدون لغيره حكمًا معه وهم يسمعونه، يقول: ﴿إِنِ الحُكْمُ إِلَّا للهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾([3])
وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾([4]).
وقال عز وجل: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾([5]).
وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾([6])، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾([7]).
وقال الله تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾([8])، وقال: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ﴾([9]).
فهذه الآيات ونظائرها قوت قلوب المؤمنين ونصرتهم النصر المبين، فإن استعاذوا من الشيطان فبأمره، وإن استولوا بنور الإيمان عليه فبوجود نصره، وإن سلموا من كيده لهم فبتأييده وبره، قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله تعالى-: «اجتمعت برجل في سياحتي فأوصاني، فقال لي: ليس شيء في الأقوال أعون على الأفعال من «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وليس في الأفعال أعون من الفرار إلى الله والاعتصام بالله: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾([10])، ثم قال: «بسم الله فررت إلى الله، واعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يغفر الذنوب إلا الله([11])».
بسم الله: قول باللسان صدر عن القلب.
ففروا إلى الله: وصف الروح والسر.
واعتصمت بالله: وصف العقل والنفس.
ولا حول ولا قوة إلا بالله: وصف الملك والأمر.
ومن يغفر الذنوب إلا الله.
رب أعوذ بك من عمل الشيطان؛ إنه عدو مضل مبين، ثم يقول للشيطان: هذا علم الله فيك، وبالله آمنت، وعليه توكلت، وأعوذ بالله منك، ولولا ما أمرني ما استعذت منك، ومن أنت حتى أستعيذ بالله منك». اهـ.
فقد فهمت رحمك الله أن الشيطان أحقر في قلوبهم من أن يضيفوا إليه قدرة، أو ينسبوا له إرادة.
وسر الحكمة في إيجاد الشيطان أن يكون مظهرًا ينسب إليه أسباب العصيان، ووجود الكفران والغفلة والنسيان ألم تسمع قوله: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾([12])، ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾([13])؛ فكان سر([14]) إيجاده ليمسح فيه أوساخ النسب؛ ولذلك قال بعض العارفين: «الشيطان منديل هذه الدار، يمسح به وسخ المعاصي وكل قبيح وخبيث، إن الله تعالى لو شاء ألا يعصى لما خلق إبليس»، وقال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله تعالى-: «الشيطان كالذَّكَرِ والنفس كالأنثى، وحدوث الذنب بينهما كحدوث الولد بين الأب والأم، لا أنهما أوجداه؛ ولكن عنهما كان ظهوره». اهـ.
ومعنى كلام الشيخ هذا أنه كما لا يشك عاقل أن الولد ليس من خلق الأب والأم، ولا من إيجادهما ونسب إليهما لظهوره عنهما كذلك لا يشك مؤمن، أن المعصية ليست من خلق الشيطان والنفس، بل كانت عنهما لا منهما؛ فلظهورها عنهما نسبت إليهما.
فنسبة المعصية إلى الشيطان والنفس نسبة إضافة وإسناد، ونسبتها إلى الله نسبة خلق وإيجاد، كما أنه خالق الطاعة بفضله، كذلك هو خالق المعصية بعدله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾([15])، وقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾([16])، وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ﴾([17])، وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾([18])، والآية القاصمة للمبتدعة المدعين أن الله لا يخلق الطاعة ولا يخلق المعصية، قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾([19])، فإن قالوا: قد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ﴾([20])، الجواب: فالأمر غير القضاء.
فإن قالوا: قد قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾([21]) الجواب: فهو على هذا التفصيل تعليم للعباد التأدب معه؛ فأمرنا أن نضيف المحاسن إليه لأنها اللائقة بوجوده، والمساوئ إلينا لأنها اللائقة بوجودنا؛ قيامًا بحسن الأدب كما قال الخضر([22]) عليه السلام: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾([23]).
وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾([24])، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾([25])، ولم يقل الخضر: فأراد ربك أن يعيبها، كما قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فأضاف العيب إلى نفسه والمحاسن إلى سيده، وكذلك إبراهيم — لم يقل: «فإذا أمرضني فهو يشفيني»، بل قال:﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء(1) إلى ربه، مع أن الله تعالى هو فاعل ذلك حقيقة وخالقه.
فقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ...﴾ أي خلقًا وإيجادًا، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 79] كما قال عليه السلام: «الخير بيديك، والشر ليس إليك»([26]) فقد علم عليه السلام أنَّ الله خالق للخير وللشر والنفع والضر، ولكن التزم أدب التعبير، فقال: «الخير بيديك والشر ليس إليك» على ما بَيَّنَّاهُ، فافهم!.
فإن قالوا: إنَّ الحق -سبحانه وتعالى- منزه عن أن يخلق المعصية لأنها قبيحة، والحق سبحانه منزه أن([27]) يخلق القبائح.
(الجواب([28])): قلنا: المعصية فعل قبيح من العبد؛ لأنَّها مخالفة للأمر؛ إذ القبح لا يرجع إلى ذات المنهي([29]) عنه، ولكن لأجل تعلق النهي به، كما أنَّ الحسن لا يتعلق بذات المأمور به، ولكن بمعنى تعلق الأمر به، فافهم!.
ثم إنَّ الحق تعالى يجب تنزيهه عن هذا التنزيه؛ وذلك أنهم إذا قالوا تعالى الله أن يخلق المعصية.
(الجواب): قلنا تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، فافهم هدانا الله وإياك إلى الصراط المستقيم، وأقامنا على الدين القويم بفضله.
([11]) يشهد لفضل هذا ما رواه أبو داود عن أنس } أن رسول الله > قال: «من قال بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله -يقال له: كفيت، ووقيت، وهديت. وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي!». اهـ.
([22]) وهو صاحب القصة المشهورة مع نبي الله موسى عليهما السلام، وهو العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علمًا، وقال عنه سبحانه ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا...﴾ [الكهف:65] إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:82]، ويذكر ابن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إنَّ لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك...» والقصة مشهورة في كتب التفسير، انظر تفسير سورة الكهف، واختلف العلماء في اسم الخضر، وهل هو نبي أو رسول أو ولي؟ وهل هو حي أو ميت؟ واتفق الجمهور أن اسمه: بليا بن ملكان، وأن الخضر لقب له، وأنه نبي، أما غير الجمهور فيرى البعض منهم أنه رسول الله، ويرى الآخرون أنه ولي وعليه الكثير، وإنما سمي الخضر —خضرًا؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء [رواه البخاري ومسلم وغيرهما].
 الرئيسة
الرئيسة