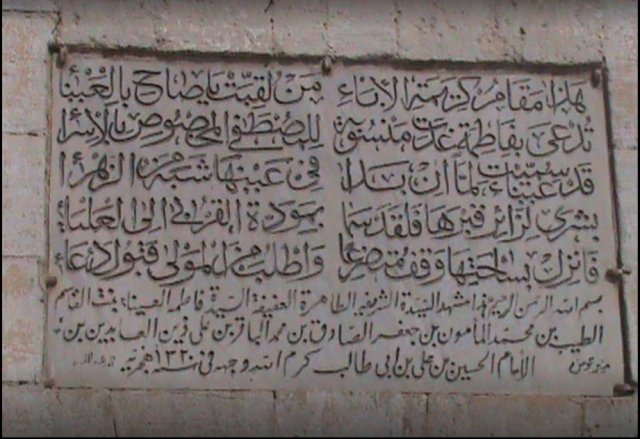لماذا يبدي الصوفية ولعًا شديدًا:
(أ) بإقامة الأضرحة؟
(ب) وبإقامة الموالد؟
(جـ) والتماس بركة الموتى ؟.. وما سند ذلك من الكتاب والسنة؟
الجواب:
(أ): الصوفية لا ييأسون من الموتى ﴿كَمَا يَئِسَ الكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ﴾
[الممتحنة:33] وهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر الإنساني الكادح إلى الله، فالميت عندهم حي حياة برزخية، وللميت علاقة أكيدة بالحي، بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، رد الميت السلام على الزائر، ومعرفته، وبتشريع السلام على الميت عند قبره، ومحادثته صلى الله عليه وسلم لموتى (القليب يوم بدر)، كما وردت في عدة أحاديث ثابتة.
ومن القرآن حسبك قوله تعالى ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 170].
فهناك إذن علاقة مؤصلة بين الحي والميت، وإلا كان الدعاء والسلام على الميت موجهًا إلى الأحجار!!
ومعنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، والسلام عليهم وتكليمهم والدعاء لهم.
وللإمام ابن قيم الجوزية (تلميذ ابن تيمية، وحواريه، ووارث دعوته) له كتاب الروح وقد أثبت فيه كل مذهب الصوفية، بما لا مزيد عليه، في موضوع الحياة بعد الموت، وعلاقة الأرواح بالأحياء، ولابن أبي الدنيا في ذلك تأليف مفيد.
والصوفية يعتقدون: بحق: أن الولي في الدنيا ولي بخصائصه الروحية، ومواهبه الربانية، والخصائص والمواهب من متعلقات الأرواح، ولا ارتباط لها بالأجسام ألبتة، فالولي حين يموت ترتفع خصائصه ومواهبه مع روحه إلى برزخه، ولروحه علاقة كاملة بقبره؛ بدليل ما قدمنا من السلام عليه ورده السلام... إلخ. ومن هنا جاء تكريم هؤلاء السادة الصالحين من أصحاب القبور.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا على قبر بعض الصحابة، وهو عثمان بن مظعونا([1])، وقال: «أتعرف به قبر أخي» وكان هذا الحديث، بعد حديث علي تبتوسية القبور المشرفة، فاستدلوا به على جواز اتخاذ ما يدل على القبر، وعلى فضل صاحب القبر بلا إغراق ولا مبالغة، رجاء استمرار زيارته، والدعاء له والقدوة به، والصدقة عليه، وحفظ أثره.
ومن هنا جاز نقل الميت من مكان إلى مكان أفضل، كما صح في حديث جابر وغيره.
ثم بالغ بعض الناس في ذلك – بحسن نية من جانب، وخوف اندثار القبر من جانب آخر – فاتخذ الأمر بالتطور الصورة التي تراها، وقالوا: إن الأمر يدور مع علته، وقد كانت علة تسوية القبور، والمنع الأول من زيارتها، هي مخافة الانتكاس والعودة إلى الشرك، وقد استقر الإيمان والتوحيد في قلوب الناس، (وإن أخطأت أحيانًا ألسنتهم) فلا بأس بعمل ما يذكر بالصالحين للقدوة والاعتبار، والقيام بحق صاحب القبر من الزيارة وغيرها.
(وقد نقلنا أراء علماء المذاهب فراجعها فيما يأتي).
هذه هي وجهة النظر عندهم بصفة عامة: وهي - على علاّتها - أبعد شيء عن التهويل بالشرك والوثنية، والكفر والردة، واستحلال دماء المسلمين، وقد مرت مئات السنين على هذه الأضرحة، فما عبد منها ضريح من دون الله، ولا صلى مسلم لولي ركعة، والمثل العملي مضروب بقبر سيدنا رسول الله × وقبور كبار الأئمة.
أما ما يكون عادة من بدع الزيارات ومناكرها، فأمور يمكن تقويمها بالتعاون على علاجها بالتي هي أقوم.
وإنني مستيقن – سلفًا بأن هذه الكلمات بالذات، ستنبري لها ألسن وأقلام احترفت خصومة هذا الرأي، واتخذته أساس مذهبها، وهو كل دعوتها وبضاعتها، ولكني أعرض الرأي، ولا أدعي العصمة، ولا أحتكر الصواب، وأرى أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه، إلا ما جاء عن الله ورسوله. بقدر ما أعرف سلفًا، كافة النصوص المقابلة، ووجهات النظر الأخرى، فالحديث هنا قديم مكرر، لا جديد فيه على الإطلاق، والتقريب بين وجهات النظر ممكن. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وارجع إن شئت إلى ما كتبناه بتفصيل عن التوسل والقبر في رسالة (قضايا الوسيلة والقبور).
(ب) أما الاحتفال بالموالد: فهو ما لم يكن بصورته هذه في الصدر الأول،
وهو – على وضعه الحالي – فيه المقبول والمرفوض، وإن كان المرفوض قد غلب فعلًا على المقبول، ولابد من وقفة إصلاح؛ فإن القائلين بالإلغاء يطالبون بغير الممكن أصلًا، ولا ينظرون إلا إلى الجانب المرفوض وحده.
إن أول من احتفل بذكرى المولد النبوي، هو الملك المظفر (طغرل) ملك (إربل) بالعراق، بموافقة الإمام أبي شامة، والعلماء.
ثم التقط الفاطميون الحبل، فزادوا وتوسعوا.
وقد التمس علماؤنا الدليل، فوجدوا أن الله كرم يوم الولادة، ويوم الموت، والبعث مرتين، مرة بلسان القرآن، وأخرى حكاية عن لسان عيسى عليه الصلاة والسلام([2]) إذن، فليوم الولادة منزلة عند الله، ثم نظروا فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازم صوم يوم الاثنين من كل أسبوع! فسئل في ذلك، فقال: «هو يوم ولدت فيه، وأنزل علي فيه». كما ثبت في الحديث الشريف.
ومعنى هذا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ذكرى مولده الشريف، شكرًا لله تعالى في كل أسبوع مرة بالصيام، وربما بما تيسر له من خير، فهو يوم من أيام الله، وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام الله، كما فعل في يوم عاشوراء، وكما فعل في (سبوع) الحسن والحسين، بالإضافة إلى ما ورد من أنه ذبح صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاثًا وستين بدنة، بعدد سِنِي عمره الشريف.
ومن مجموع هذا، وما هو منه، يمكن استنباط مشروعية إحياء الموالد، لما فيها من الذكريات النافعة، والعبر الموجهة، وبما فيها من تلاوة القرآن، والوعظ والإرشاد، والذكر الصحيح، والثقافة، ثم بما فيها من التعارف على البر والتقوى، والرواج الاقتصادي والصدقات، والحركة الاجتماعية؛ فهي بهذا الوصف أسواق خير ونفع عام لا تضيق به أصول الأحكام الشرعية، ولا فروعها، بل إنها تدعو إليه، وتحض عليه
ثم إن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[الأنبياء:107]. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا رحمة مهداة». وقد أمرنا الله تعالى أن نفرح بفضله ورحمته ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]. فإحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشروع من العبادات والخيرات ونحوها، إنما هو فرح برحمة الله، فهو تنفيذ لأمره تعالى.
كذلك نحن مأمورون بالشكر على النعمة، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النعمة العظمى فإحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بشروطها: نوع من شكر النعمة، وهو واجب قرآني صريح.
وعلى نحو ذلك أو بعضه ينسحب حكم مشروعية إحياء ذكريات موالد أولياء الله جميعًا، بشروطها المقررة.
وهنا يجب أن نقرر أيضًا القاعدة العلمية الثابتة: بأنه ليس كل ما لم يكن حرام في الصدر الأول هو حرام، وإلا فلم يبق في حياتنا شيء حلال.
وفيما عدا هذا – مما اندس في هذه التجمعات من المفاسد الخلقية والدينية والاجتماعية وغيرها – فالحكومة والصوفية الرسمية، والجمهور، هم المسئلون جميعًا عنها، في الدنيا والآخرة. وهو شيء عم وطم وأورث الهم والغم.
 الرئيسة
الرئيسة