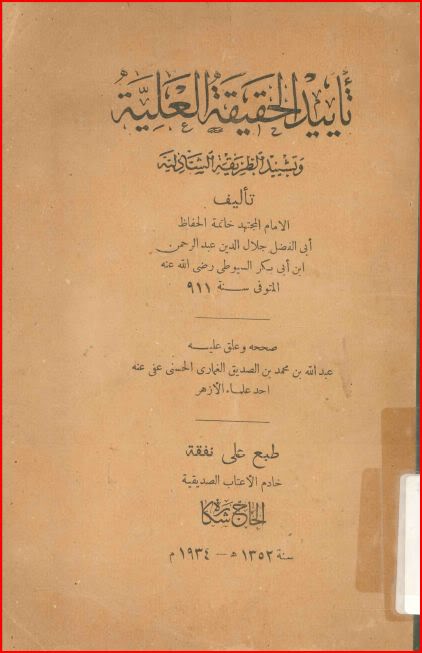باب في الاتحاد والدليل على بطلانه
اعلم أنه قد وقد في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد, فإن الاتحاد عندهم هو الغلو في التوحيد, والتوحيد معرفة الواحد الأحد, فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله, فغلطوا وهلكوا بذلك.
(فصل) الدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين محال, فان رجلين مثلا لا يصير أحدهما عين الآخر لتباينهما في ذاتهما كما هو معلوم, فالتباين بين العبد والرب تعالى أعظم.
فإذا أصل الاتحاد باطل.
وحيث يطلق الاتحاد ويقال: هو هو لا يراد ما هو محال في نفس الأمر, وإنما يكون بطريق التوسع والمجاز, كقول الشاعر:
| أنا من أهوى |
* | ومن أهوى أنا |
فالشاعر لا يعني أنه هو تحقيقًا بل كأنه هو.
والعبد الموحد إذا عرف الحق الواحد وانتفت عنه الكثرة, فهذا المقام سمي بلسان المجاز اتحادا, وبلسان الحقيقة توحيدًا.
بيان ذلك أن المؤمن معه نور هو سر الله تعالى يصاحب العبد, به يطلب العبدُ اللهَ تعالى, ويذكره, وبه يريده ويعرفه, وبه يوحده ويحبه ويشاهده, ولولا ذلك النور من الله تعالى معه لا طلبه ولا أراده ولا ذكره, ولا عرفه ولا أحبه, كما قيل: لا يحمل عطاياه ولا مطاياه.
فمن رفع الله تعالى الحجاب عنه, وأشرق على قلبه النور الرباني, واستنار بالنور, وخرج من ظلمة وجوده صار الحكم للغالب ﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: من آية 21], فعند ذلك تعدم آثار بشريته لغلبة ما تأثر به من النور الرباني, فيكون كما قال الشاعر:
| أنا من أهوى |
* | ومن أهوى أنا |
ومن هذا الموضع قامت الدعوى وما تكلمت به الرجال والمحققون من الاتحاد والسبحانية لم يريدوا بذلك ظهورا على العالم, وافتخارا عليهم, وإنما أرادوا محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه.
وأيضا في هذا المقام ربما يجري على لسان بعضهم: هو الطالب والمطلوب, وهو الذاكر والمذكور, وهو المحب والمحبوب, وهو الشاهد والمشهود, إضافة إلى السر الذي يصاحبه من الله تعالى, فعند ذلك يظن المحجوب الجاهل بسنة الله تعالى أنه اتحاد حقيقة, وشبهوا ذلك بضوء السراج والكواكب مع نور الشمس, وغلطوا في ذلك, فإن ضوء السراج له وجود في نفسه ما اتحد بنور الشمس بل استتر عنه, غلبه نور الشمس, ولو كان هذا اتحادا لكان ينبغي إذا غربت الشمس أن يغرب معها ضوء السراج والكواكب, وليس كذلك, بل اتحاد العبد مع الرب تعالى, وحلوله فيه محال باطل بإجماع المسلمين: الأنبياء والأولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء. وليس هذا مذهب الصوفية, وإنما هذا مذهب الطائفة الحلولية, قالوا هذا اتحاد العبد مع الله تعالى, لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالىٰ. قال تعالىٰ: ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ﴾ [آل عمران: من آية 176]. فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: اتحد ناسوته بلاهوته. الناسوت: هو الإنسان, واللاهوت, هو الإله. وكل ذلك باطل مردود, واتحاد العبد بالله تعالى محال.
وأما من حفظه الله تعالى بالعناية الأزلية إذا وصل إلى هذا المقام علم أن هذا غلبة نور الحق سبحانه على نور العبد, واستتار نوره في نور الحق تعالى, وليس اتحادا ولا حلولا. وسموا هذا المقام مقام الجمع, وجمع الجمع, وعين الجمع, لوجود القرب البليغ من الحق تعالى, لا بالمكان, بل بالقبول ورفع الحجاب وإظهار التجلي في سره, فإن مشرب خواص العباد إنما هو من مشاهدة نور الحق سبحانه.
ومعنى الجمع على اصطلاحهم: أن يشاهد الحق عند فعله بقلبه.
وجمع الجمع: أن يشاهده بسره دائما, ويشاهد ما دونه, وهو التمكين. وهذا المقام إنما يتحقق للعارف بأن ينظر في حال وجوده إلى نفسه, فيراه كما كان في حال العدم, ويعرف أن قدرة الله التي معه اليوم هي القدرة التي كانت في الأزل, ويقول: أنا أسير القدرة الأزلية أرى اليوم نفسي كما كنت في الأزل, فما كان له قبل الوجود اختيار, فكذلك لا يكون له بعد الوجود اختيار فيكل أمره إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿فاتَّخِذْهُ وَكِيلاً﴾ [المزمل: من آية 9], فلا يكون كما يريد هو, بل يكون كما يراد به, وهذا مقام التسليم والرضى بما قضى.
(فصل) لو كان العبد متحدا مع الله تعالى لكان ينبغي أن يكون عالما بالذات, كما أن الله عالم بالذات, فوجب أن يعلم جميع المعلومات, ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
كما أن الله تعالى كذلك, ويستحيل في العالم شيء لا يعلمه, فان الله تعالى بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء.
ومن المعلوم ضرورة أن أمر العبد بخلاف ذلك, وقد قال تعالى لخير خلقه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: من آية 9]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي﴾ [الأعراف: من آية 187].
وقال: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: من آية 188].
فهو الذي شرفه الله تعالى بقوله: «لولاك لما خلقت الأفلاك»([1]).
ولما وصل ليلة أسري به إلى مقام لم يصل إليه أحد قط من المخلوقات نادى إسرافيل وقال: محمد حي كذا. فوفقه([2]) الله العجز عن إتيان ثنائه. فقال: أولا: (أعوذ بعفوك من عقابك), ثم عبر عن صفة الفعل.
وقال ثانيا: أعوذ برضاك من سخطك, فعبر عن صفات الذات.
وقال ثالثا: أعوذ بك منك. وترقى من تلك المقامات, واعترف بالعجز عن إتيان ثنائه فقال: لا أحصي ثناء عليك([3]).
فهذه مقامات شريفة وكرامات منيفة, وهي مع هذا مخصوصة بصفة الإثنينية من حيث الإضافة إلى صفة أنت وأنا فعبر بالعواطف اللاهوتية, حتى وصل بايصاله إلى سرادقات الهوية, ونطق بكمال توحيدات الأحدية بقول: «أنت كما أثنيت على نفسك».
وإذا عرفت ذلك في العلم فكذلك في القدرة, فان الله تعالى قادر على جميع المقدورات, ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, ويعلم ضرورة أنه لم يقدر أحد من الأنبياء والأولياء على ذلك, إذ لو كان قادرا لعمل لنفسه كل ما شاء حيث شاء, ويؤخر في أجله إذا أراد ذلك.
وكذلك السمع والبصر, وجب أن يسمع كل المسموعات في السماوات والأرضين وما تحت الثرى, فان الله لا يخفى عليه شيء من المسموعات والمبصرات.
وكذلك وجب لمن يدعي الاتحاد أن يحيا حياة لا يموت أبدًا, كما أن الله حي لا يموت أبدًا, ومعلوم من أحوال الناس خلاف ذلك.
(فصل) من ليس له قدم راسخ في المعقولات ربما يغلط حين ينظر في مرآة أو مياه لاح فيها صورته, فيظن أن تلك الصورة هي صورة وجهه في المرآة, وليس كذلك, وينظر في المرآة ويرى وجهه في المرآة, وهو لا يشك أن وجهه ما حل في المرآة ولا اتحد بها.
كذلك نور الحق تعالى إذا تجلى في مرآة قلب العبد عند صفائه ما حل في قلبه, ولا اتحد به.
وكذلك المرآة المصقولة إذا حاذت جرم الشمس ينطبع فيها نور الشمس لا محالة, فلا يكون النور المنطبع فيها نفس الشمس.
فذلك نور الصفات والذات إذا ظهر في مرآة القلب, فلا يكون نفس الصفات والذات, قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً﴾[الأعراف: من آية 143] فالحق -جل جلاله- حين تجلى للجبل ما حلّ في الجبل, وإنما ظهر, كما قلنا في مثال المرآة فافهم, فإن الاتحاد والحلول باطل مردود, شرعًا وعقلاً وعرفًا.
[مسألة قد يذكر الاتحاد]
(مسألة) قد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاء الموافقات, وفناء حظوظ النفس من الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة, وفناء الأوصاف الذميمة وبقاء الأوصاف الحميدة, وفناء الشك وبقاء اليقين وفناء الغفلة وبقاء الذكر.
[قول من قال سبحاني]
(فصل) قول من قال: سبحاني ما أعظم شأني, لا إله إلا أنا فاعبدني. يحمل على الحكاية.
وكذلك قول من قال: أنا الحق, أنا الله. محمول على الحكاية.
ولا يظن بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد, لأن ذلك غير مظنون بعاقل, فضلا عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات.
وقال بعضهم: معنى قول أبي يزيد رحمه الله إن صح عنه: سبحاني ما أعظم شأني, كقوله رحماني ورباني وسلطاني إضافة إلى نفسه.
وما أعظم شأني إذ أنت سبحاني يعني: أنت لي, وقيل: علو الهمة أجرى على لسان أبي يزيد (سبحاني) وعلى لسان غيره (أنا الحق وأنا الله) تحققا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تخلقوا بأخلاق الله»([4]).
([3]) في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «فقدت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» وكذا هو في السنن الأربعة ومستدرك الحاكم.
 الرئيسة
الرئيسة