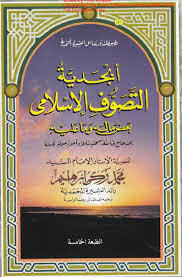السؤال العاشر
(أ) ما هو الحكم في استخدام الرقص والطبل والزمر والغناء (والحركات غير اللائقة في كثير من حلقات الذكر)؟!
(ب) تحريف أسماء الله تعالى؟!
و ( أه، أه) أو ( هه، هه)؟!
(جـ) ترديد لفظ (هو آه)؟!
(د) إصدار الأصوات الساذجة بنحو (ها) و(أه، أه) أو (هه، هه)؟!
(هـ) اشتراط أن يتخيل الذاكر شيخه بين عينيه؟!
(ز) الاعتراف للشيخ بالذنوب والمعايب؟!
الجواب:
أشرتم إلى أنني – وأستغفر الله – من قادة الفكر الديني المعاصر، وأحد المصلحين الصوفيين، فجزاكم الله عن حسن الظن بحسن الثواب.
وأنا امرؤ أعرف – بحمد الله – نفسي فلا أعدو قدري. ولا أستشرف إلى هذه القيمة المتسامية، لكنني لا أنكر فضل الله علي في أنني شاركت – بكل طاقتي – فيما زعمت لنفسي أنه يرضي الله – من خدمة التصوف خاصة، والإسلام والوطن عامة، ولا أزال بحمد الله رغم ما أعاني.
ولابد من تسجيل حادث تاريخي فريد، مما عانيت في سبيل الإصلاح الصوفي (ولا أزال)؛ ففي الخمسينات، عندما ألححت في المطالبة بالتطوير، والإصلاح الصوفي، حتى استجابت الحكومة، وألفت لجنة للإصلاح الصوفي برياسة محافظ القاهرة، وكنت مقرر هذه اللجنة بوصفي صاحب الاقتراح، وخبيرًا في الشئون الصوفية، ثم شكلت لجنة من بعدها برياسة وزير الأوقاف لنفس الغرض، وكنت مقررها أيضًا لنفس السبب (وكان الوزير فضيلة الأخ الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله تعالى).
من أجل ذلك: اجتمعت الجمعية العامة للطرق الصوفية من أكثر من ستين شيخًا بمسجد الإمام الحسين، وقررت بالإجماع (فصلي نهائيًا من الطرق الصوفية) وتجريدي من النسبة إليها!!
وكانت هذه أول مرة في التاريخ الصوفي الرسمي، يفصل فيها (شيخ)!! حتى رد «مجلس الدولة» إليّ اعتباري!؟ وكانت قصة، إنما هي غصة، ويكفي التلميح إليها لتعرف كيف أحيا ماضيًا على شظايا الزجاج المحطم بين (أعداء) التصوف، و(أدعيائه) وهذا قدري، ولا يزال.
ثم كان من فضل الله: أن استمرت الحكومة في النظر في هذا الإصلاح على أساس مذكراتي وتقريراتي السالفة، وغيرها، حتى صدرت اللائحة الصوفية الأخيرة – بعد ولادة طويلة عسيرة – كخطوة كبيرة، في سبيل تطهير التصوف وتطويره وإصلاحه، وقد سجلت بعض ملاحظاتي عليها، وإن كانت اللائحة في مجملها شيئًا حسنًا في خدمة تصوف المسلمين – إن أمكن التطبيق الصحيح – رغم ما لي عليها من مآخذ أساسية.
وبعد:
أولًا: فأما استخدام الرقص، والطبل، والزمر، والغناء – فيما يسمى حلقات الذكر – فليس من دين الله (قولًا واحدًا) ساء عند أئمة الصوفية، أو غير الصوفية، وإنما هو من الدخيل، والدسيس الذي تسلل إلى التصوف، فأفسده، وأساء إليه.
ينقل الشيخ ( ابن الحاج) في مدخل ( الشرع الشريف):
قلنا: وقد عاب الله نحو ذلك على المشركين من قبل، فقال: ]وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَة[ [سورة الأنفال: 35] يعني تصفيرًا وتصفيقًا! وهما من لوازم الطبل والزمر والرقص!!
إن الرقص، والطبل، والزمر، لا شك هو لهو ولعب، فإذا اتخذناه دينًا، كان افتراء على الله، وهو تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ [الأعراف: 51]، و﴿لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ [الأنعام: 70]. كما في آيتي (الأنعام والأعراف) والله لا يأمر بترك شيء هو قربة إليه، فإذا كرر الأمر كان معنى هذا أنه شيء يغضب له غضبًا مضاعفًا، لما فيه من تعدّ عن حدوده تعالى، وعلى حدوده، يقول شاعر الصوفية:
|
يا عصبة ما ضر أمة أحــمد |
* | وسعى على إفسادها إلا هي |
| طار، ومزمار، ونغمة شادن |
* | أتكون قط عبادة بملاهى ؟! |
وإنما يعبد الله بما شرع وفيما شرع تعالى سعة وكفاية، ومتعة روحية بغير حدود، والعبادة جد كلها، وهو تعالى يقول: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ=١٧- بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء:17 ، 18]. ومن شاء لهوًا مباحًا، فليبتعد به عن العبادة، وعن التصوف.
ولوجه الله، وللحق في ذاته ورغم ما أصابنا، ولا يزال – في سبيل التجديد والإصلاح الصوفي – نقرر أن مشيخة الطرق الصوفية المعاصرة، أصدرت عدة منشورات، تنهى فيها عن هذا العبث، ولكن هناك أهواء، وخلفيات، ومواريث ومصالح، ونوع من الجهلوت([1]) المستحكم، والاقتدار، بل الإصرار على المخالفة كل ذلك يقف دون التنفيذ الواقعي لهذه المنشورات، حتى كأنها لم تكن، ولكن لابد لهذا الليل من آخر.
ثانيًا: أما الغناء والإنشاد، فإن كان ملتزمًا، وبشروطه المشروطة شرعًا، فإن
له أصلًا في السنة الصحيحة؛ ففي البخاري وغيره أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه – وهو يشارك في بناء مسجده الشريف ينشدون:
| اللهم لولا أنت ما اهتدينا سقاني |
* | ولا تصدقنا ولا صلينا |
| فانزلن سكينة علينا سكره |
* | وثبت الأقدام إن لاقينا الثاني |
إلى آخر ما قالوا بأصوات منغمة طبعًا على لحون العرب!!
كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يردد نحو هذه المقاطع على من كان ينشد مع المرددين من الصحابة، سواء في بناء المسجد، أو حفر الخندق أو غيره، وقد استمع صلى الله عليه وسلم: حداء «عبد الله بن رواحة» وأقره، وحسبك في رضاه صلى الله عليه وسلم عنه قوله لابن رواحة يوما عندما تزايد خطو العيس «الإبل» على حدائه أن قال له صلى الله عليه وسلم: «رويدك، رفقًا بالقوارير».! يريد النساء من خلف الركب، منهن من لا يقوين على شدة خطو الإبل المأخوذة بجمال الحداء وحسن الصوت، ورقة الأداء والتلحين([2]).
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع لبعض «الأراجيز» في بعض المناسبات والأراجيز شعر ينشد منغمًا بلحن عربي موروث، فهو ضرب جاد من الغناء العفيف، فضلًا عما كان يستمعه من الشعر (بلحون العرب) وأصواتها بمسجده.
وتأثّر النفس الشريفة باللحن والصوت الجميل طبيعة في الإنسان الكامل، لا ينكرها رجل سوي قط، ألا ترى أنه سوف يكون من متع الجنة أن يستمع أهلوها كلام الرحمن عز وجل، وكيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلالًا) للأذان، وكيف كان العرب يضربون المثل بصوت وأداء (أبي محذورة) أحد مؤذني النبى صلى الله عليه وسلم ، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أقام منبرًا لحسان في المسجد ينشد الشعر عليه منافحًا.
ولقد استمع صلى الله عليه وسلم لصوت ابن مسعود، فقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود([3]). كما جاء في الحديث الصحيح.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن، ترتيلًا يأخذ بمجامع قلوب الصحابة فيتمنون لو أنه أطال وبالغ.
وفي الصحيحين حديث: «حسن استماع الله للنبي حسن الصوت بالقرآن»([4]).
ثم ألا ترى أن الله أبغض الصوت الكريه، فقال تعالى:﴿إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ﴾ [لقمان: 19]!! ومن مجموع هذا، وها هو منه (وهو كثير). يمكن الحكم على الإنشاد الملتزم بالمشروعية على أقل صور الأحكام، إن لم يكن السنية، أو الندب، أو الاستحسان؛ فإن من الإنشاد ما يرتقي بالمرء إلى أسمى معارج الأرواح، إذا كان رقيق القلب شفيف الروح.
وقد أُثر عن بعض كبار شيوخ الأزهر، قوله: (من لم تطربه الأوتار، على شواطئ الأنهار؛ في ظلال الأشجار، وغريد الأطيار، وجوار الأزهار، والنسيم المعطار، ذاكرًا فردوس العزيز الغفار: فهو حمار من حمار...).
ثالثًا: أما تحريف أسماء الله الحسنى في حلقات الذكر: فإجماع أئمة التصوف على أنه حرام موبق، وحسبك فيه قوله تعالى: ﴿وَللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180]. فهنا أمر بالذكر، مع نهي شديد عن تحريفه والتحذير عن الصلة بمن يحرفونه، أي يلحدون فيه، وإعلان أنهم سيجزون بسوء عملهم، فيكون هذا الإعلان بمثابة إنذار،
ونهي شديد مكرر، حتى ندع من يحرفون أسـماءه تعالى، فكيف بحـكم المحرفين أنفسهم !؟
وهذا الإلحاد يشمل نحو قولهم «ها، ها» أو « هي، هي» أو « أه، أه » وغير ذلك من الأصوات الساذجة الحمقاء، التي لا تكون أبدًا من كرام الناس، ولا أفاضلهم: لا أسلوبًا، ولا أداء.
لكن المأخوذ عن نفسه، لا يؤاخذ؛ لأنه ممن رفع عنه القلم ولهذا وجبت التفرقة الشرعية بين هذا وذاك.
وفي هذا يقول الشيخ الأخضري في أرجوزته الصوفية:
|
أبقوا من اسم الله حرف الهاء سقاني |
* | فألحدوا في أعظم الأسماء |
| لقد أتوا والله شـــيئًا إدًا |
* | تخر مــنه الشامخات هدا |
ويلحق بهذا نطقهم باسم (الله) على غير وضعه الشريف، من نحو ضم ألفه الأولى أو كسرها، مع قصر ألفه الوسطى، ومع تخفيف لامه أو تغليطها، مما يخرجه عن منطوقه القرآني إلى منطوق سوقي محرم، وخصوصًا مع ما يسمونه (الدوكة) أى تغليظ الصوت.
أما قولهم ( هو، هو): فهذا اللفظ (ضمير الغائب لغة) وقد ورد في القرآن الكريم كثيرًا من نحو قوله تعالى: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آية الكرسي البقرة:255] وقوله: ﴿هُوَ الحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [غافر: 65] فهو الغائب عن النظر، المشهود بالبصيرة، وقد أفرد الإمام الفخر الرازي في تفسير الفاتحة بحثًا ضافيًا، أثبت فيه أن لفظ (هو) ربما كان اسم الله الأعظم – بنحو عشرين دليلًا، ونحن في ذلك معه.
فالمسألة في لفظ (هو) - على أسوإ الأحوال - خلافية، ومادام في الأمر وجهان ودليلان، فإنه يسعنا ما يسع غيرنا وليس من العدل تجريم من اختار أحد الوجهين لصحة دليله عنده، والفروع كلها محل خلاف!!
والقاعدة: «متى دخل الاحتمال، بطل الاستدلال».
( جـ) أما لفظ (آه) فلم يثبت علميًا أنه ذكر به إمام الشاذلية (أبو الحسن) ولا كبار تلاميذه – من أمثال: أبي العباس المرسي، وابن عطاء الله، والشيخ الحنفي، ولم يرد له ذكر في أهم مراجع التاريخ الشاذلي، كــ «درة الأسرار» و«المفاخر العلية» ، «واللطائف» ولكنه منسوب إلى بعض كبار أئمة الشاذلية المتأخرين، ولهم على مشروعية الذكر به أدلة شتى، لعل من أقواها، وأحكمها ما كتبه المرحوم الشيخ الظواهري شيخ الأزهر الأسبق، ثم ما كتبه المرحوم الشيخ عمران الشاذلي في عصرنا الحديث.
ثم إن الذاكرين بهذا الاسم يقررون: أن له أثرًا عظيمًا بالممارسة والتجربة ولابد من مراجعة أدلتهم قبل الحكم لهم أو عليهم.
فهو أيضًا نمط من الخلافات الفرعية. ومن الشاذلية من لا يذكرون به، (كالحصافية، والحامدية، والمحمدية) ومن أشد الناس تمسكًا به فروع (الفاسية الشاذلية).
وكان والدي رضي الله عنه لا يستهجنه، ولا يستحسنه، ويقول: (أنا لا آمر بهذا الاسم، ولا أنهى عنه).
وكان يقول: (إن عذري معي في التوقف في هذا الاسم بما له، وما عليه، وما خلاف عليه خير مما فيه الخلاف).
قلنا: ونحن على الأثر؛ فلا نعيب على من يذكر به بدليله، ولا نلوم من لا يذكر به لدليله.
رابعًا: وفيما يتعلق باشتراط تخيل المريد شيخه عند الذكر بين عينيه: فهم يقولون: إن المراد الأساسي من هذا، هو استجماع الهمة، وطرد الشواغل، وتفريغ القلب لحسن التوجه، والاستعداد للاستمداد، فهو وسيلة – مؤقتة – للتجهيز لدخول حضرة الحق، فإذا ما انحصرت الطاقة في تصور الشيخ، والنبي، وهما يدفعان المريد إلى الله، ويهيئانه للعمل، ثم إذا أخذ المريد في الذكر، كان أول ما ينطرح على المريد هو هذا الخيال الفاني، فلم يبق إلا الله الباقي.
هذا هو أصل الموضوع عندهم.
وتخيل صورة الشيخ ليست شرطًا، ولكنها من الوسائل الاجتهادية والتجريبية النافلة. ولهذا لم يقل بها كثير من الشيوخ، اكتفاء بصدق المحبة، والرابطة بين المريد وشيخه ونبيه صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه بينهما.
وفي هذا الموضوع بحوث نفيسة عميقة.
وإذا عرفنا أن هذه الحالة – عندهم – إنما تكون قبيل البدء في التعبد، ولمدة لحظات فقط. ثم يكون الذكر الذي يستغرق كل أحاسيس الذاكر.
إن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ عند الذكر، أشبه شيء بما يخطر على بال المصلي من أخيلة الجنة والنار، والإنس والجن، وأهوال الحشر، وعظمة الله، وهذه صور لا تبطل الصلاة، ولا تتهم بالوثنية. فالموقف هنا وهنا واحد، وبالتالى يكون الحكم واحدًا؛ فقد انتفت دعوى الوثنية، التي يرمى بها الصوفية – أو بعضهم – في هذا المجال، تهورًا أو مجازفة.
خامسًا: ثم تأتي قضية اعتراف المريد لشيخه بذنوبه وعيوبه، فأي حرام في هذا؟
إنك عندما تذهب إلى الطبيب تذكر له كل ما تشكوه، وما يؤلمك.
وهذا الشيخ هو طبيبك الروحي في الله، وعقدة الذنب تؤرق صاحبها، فهو يسأل طبيبه الروحي عما عسى أن يطهره ويغسله من خطاياه، وينقذه من آلامه، ووخز الضمير، وهو (النفس اللوامة) في لغة القرآن والتصوف.
أليس كان يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول أحدهم مثلًا: «هلكت يا رسول الله، فقد فعلت كذا وكذا» كما حدث مثلًا في قصة «ماعز» وقصة «الغامدية» واعترفهما بارتكاب الخطيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره البخاري ومسلم وغيرهما فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدل المعترف بخطئه على ما لو عمل به تقبله الله، وعفى عنه؛ فإن من الفطرة ضرورة الإفضاء والاستنصاح «والدين النصيحة»([5]).
أليس الله يقول ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾[الأنبياء:7].
ثم أن الآيات القرآنية كلها تدل على أن المؤمنين – بل وغير المؤمنين – كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبئونه، ويستفتونه، في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ..﴾ الآية [الأنعام:54]. وقوله تعالى: ]وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ...﴾[النساء: 64] وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ...﴾ [المائدة: 42]وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ...﴾[الممتحنة:12].
فكلها حث على المجيء إلى أهل الصلاح وطلب النصح منهم، أو الفتوى، أو التوجيه، ولا يكون ذلك إلا مع بيان طلب الاستيضاح أو الاستفتاء، فكان هذا جميعًا من أسباب الإفضاء إلى الشيخ بالذنوب أو العيوب، طلبًا للتعرف على ما يرضي الله، وما يكون سببًا للإنابة والمتاب.
ثم أليس يستشير الرجل من هو أعلم منه، ليستفيد من تجربته أو خبرته أو سوابقه في معاناة الأمور؟
أليس يفضي الأخ إلى الأخ بما يؤرقه ويقلقه طالبًا نصحه وتوجيهه؟ وهل اتخاذ الشيخ إلا من أجل تنقية النفس من أوضارها، وترقيتها في معارج السالكين؟
فلست أرى ممنوعًا – شرعًا، أو وضعًا – أن يطلب المريد نصيحة شيخه فيما واقعه من مثالب وخطايا، ليدله على وسيلة النجاة، وفي القرآن ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...﴾ [الشورى:38].
وأظن ما قدمته كافيًا الآن، في هذا المجال.
ولا اعتراض بأن: هذا يشبه نوعًا من الكهنوت في الاعتراف لرجال الدين([6])، فالفارق هائل ضخم؛ فهناك يعتقدون أن مجرد الاعتراف كاف في محو الخطيئة، وأن الاعتراف الذي يقبله الكاهن، يقبله الله حتمًا.
أما هنا: فإنما يدل الشيخ مريده على ما به يرضى الله عنه، من توبة واستغفار أو صدقة، أو عبادة، ثم يدعُ ما وراء ذلك لله وحده، إن شاء قبل، وإن شاء لا، وهذا فارق ما بين الشرك والتوحيد.
([2]) تواتر أنه صلى الله عليه وسلم استمع إلى غناء الجواري، عند دخوله المدينة كما استمع إلى المرأة التي نذرت أن تضرب له الدف وتغني.
([3]) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد والنسائى، وابن ماجه عن أبي هريرة والنسائى عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها.
وروى أبو نعيم في الحلية قوله صلى الله عليه وسلم عن أنس: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود». وروى محمد بن نصر: «وقد أوتي أبو موسى من أصوات آل داود».
([5]) رواه البخاري في التاريخ عن سيدنا ثوبان رضى الله عنه، والبزار عن عبد الله بن عمر رى الله عنهما.
السؤال الحادي عشر
 الرئيسة
الرئيسة