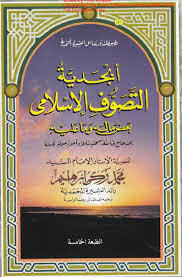الباب الثاني أسئلة جريدة الأهرام
سألها الأستاذ الكاتب المعروف الأستاذ «سامي دياب» قال:
السؤال الأول
يقولون: إن التصوف استقى نظرياته في الحلول، والاتحاد، والوحدة، وحكمة الإشراق، وكل هذا من مبادئ الشيعة الرافضة، والإسماعيلية، ومصادر أخرى أجنبية، كالعقيدة الفارسية، والمذاهب الهندية والنصرانية، فابتعد التصوف بذلك عن تعاليم الإسلام.
الجواب:
للناس أن يقولون ما يشاءون، ما دام لا يربطهم علم منصف، ولا خلق عاصم، ومن البديهيات، أن التصوف الإسلامي في ذاته شيء، وما اندس فيه أو دخل عليه شيء آخر، والحكم على الشيء بما اندس فيه: حكم على المدسوس، لا على الشيء نفسه، وما أضر العلم إلا أساليب التعميم والتهويل، والعصبية للرأي بلا تحفظ ولا احتياط.
إن التصوف الإسلامي هو: روح الكتاب والسنة، قولًا وحدًا. أقر به كافة أئمة الصوفية، من السلف والخلف، وأقر به المنصفون من الأجانب، الذين تحدثوا عن التصوف، وقد عرفوا التصوف بعشرات التعريفات، التي تدور كلها في هذا المجال، باختلاف منازل الرجال ومواقف السلوك، فإذا اندس على هؤلاء السادة ما ليس لهم به علم، فقد اندس من قبل في كتب الفقه، والتوحيد، والسيرة النبوية، بل في كتب الحديث الشريف، والتفسير، ما لا قبل لهذه العلوم به، ولكن الله ندب من أهل العلم من ميزوا الخبيث من الطيب، فلم يترك الناس الفقه، ولا التوحيد، ولا التفسير، ولا السيرة، من أجل الدخيل، أو الدسيس فما أخذ علماء هذه المواد بما مزجه الوضاعون في علومهم، ولا تركوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجل آلاف الموضوعات والأكاذيب التي تسربت إليها.
وكذلك بقية علوم الدين.
لقد حاولوا أن يدسوا على كتاب الله ما ليس منه، والنبي حي، والوحي ينزل، وما قصة الغرانيق بمجهولة عند طلبة علوم الدين (على ما قيل في سندها أو تاويلها).
وهكذا يكون من العجيب، أن يحاسب الصوفية على جريمة غيرهم، أن يؤخذوا بخطإ لم يرتكبوه، بل هم قد نبهوا عليه، وحذروا منه، وراجع إن شئت ما كتبه (ابن الحاج) وهو من خاصة الصوفية في كتابه (مدخل الشرع الشريف) وراجع بإمعان شرح الإمام السلفي المعروف (الشيخ ابن القيم الجوزي) على كتاب إمام الصوفية الكبير (الشيخ الهروي) رضي الله عنهم جميعًا، ثم ما كتبه الإمام «الأخضري» في أرجوزته الصوفية الكبيرة من متأخري الصوفية، وما كتبه أخيرًا الشيخ حسنين الحصافي، ومن قبله الشيخ أبو عليان الشاذلي، ثم الشيخ إبراهيم الخليل بن علي الشاذلي، ثم الشيخ عمران الشاذلي، ثم المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية، وهو من كبار أقطاب الصوفية باعترافه المكرر في كتبه، وبطريقته المفصلة في رسالته المسماه «العهد الوثيق»([1]) وإن كره الكارهون.
ثم ما كتبه الشيخ (حسن البنا) الذي مزج دعوته بالتصوف الراشد مزجًا كان السبب الأول في نجاحها وانتشارها، ومن قبل هؤلاء كتب «محمد عبده» خير ما يكتب عن التصوف المستنير، شأن كل منصف يريد وجه الله.
ولا يقبل الاحتجاج بأمثال الحلاج، وابن عربي، والجيلي، ومن حذا حذوهم، ممن نقلوا التصوف من العمل إلى المنطق والتنظير، فليس هؤلاء هم كل الصوفية، فهم لم يزيدوا عن عدد الأصابع – عند التسليم بأنهم شطحوا، أو تطرفوا، أو تغالوا، أو حتى انحرفوا – وهم بشر، اجتهدوا، وما كتبوه قابل للتأويل، وحسن التوجيه عند المنصفين، فهو ليس للعامة وأمرهم فيه إلى الله من قبل ومن بعد.
ومن الظلم الشائن أن يقف الناقدون عند هؤلاء، وينسوا أمثال الجنيد، والقشيري، والسلمي، وابن زروق، وابن عطاء الله، وأبي طالب المكي، والهروي، والسهروردي، والغزالي، والسيوطي، والسنوسي، والدردير، وأمثالهم، سلفًا وخلفًا وهؤلاء أيضًا بشر لهم خطأ وصواب.
ولكنهم من باب غير الباب.
إن التصوف هو: «التقوى» وهو «التزكية» قولًا، وعملًا، وحالًا: حقيقة، ومثالًا، وسيلة، وغاية، فعلًا وأثرًا، فما لم يكن كذلك، فليس من التصوف، ووزره على صاحبه وحده، وكما لا يتحمل المسئلون أوزار المنحرفين من أهل القبلة، فليس من الدين ولا من الخلق أن يتحمل الصوفية الشرعيون أوضار من سبوقهم بالانتساب إلى التصوف؛ فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
ثم إنه لم يعد بيننا اليوم من يفهم رموزهم أو يقول بأقوالهم، أو يعتقد عقيدتهم - إن صح كل ما قيل عنهم - ولا تنس كيف دسوا على الشعراني في حياته، كما سجله في كتبه، فكيف بعد مماته!
التصوف – يا ولدى – هو ربانية الإسلام، هو: الصفاء، هو بركة السماء، هو الحب: حب الله، من حبه ينبثق حب أحبابه، وحب ما من أجله خلق الإنسان.
***
السؤال الثاني
عندما يلغز الصوفية في أشعارهم وأناشيدهم بلفظ (ليلى، والكأس، والخمر) ونحو ذلك تعبيرًا عن مواجيدهم، ألا ترى في ذلك نوعًا من تسرب الطبيعة المكبوتة، وجهرًا بها؟
الجواب:
اختار بعض الصوفية الإلغاز والإشارة والتحجية باستعمال المجاز والكناية، والاستعارات، والرموز اللغوية، تعبيرًا عن أذواقهم، ومواجيدهم، وأشواقهم. حتى اختصوا بذلك وعرفوا بأهل الإشارة لأسباب عدة منها:
(أ) عدم مساعفة الألفاظ والعبارات المألوفة لتصوير مداركهم ومشاعرهم؛ فكان اللجوء إلى الإشارة والرمز ضرورة، لقربها من حسن عرض المشاعر والأحاسيس، وتصويرها، والتعبير عنها.
ثم إن لكل علم مصطلحًا مستحدثًا، وهذا اصطلاحهم الخاص بهم – فلماذا يؤاخذون على أنهم استقلوا بنوع من الاصطلاح، ولا يؤاخذ بقية أصحاب العلوم والفنون والحرف وغيرها؟!
(ب) ومنها ظروف البيئة، وفسادها بالتسلط والبطش، والقهر، والعدوان واضطراب الرأي، ثم الرغبة في إثبات الكيان الذاتي، والشخصية المستقلة للدعوة، والحرص على عدم تميع خصائصها، والتلويح بأنها طريق الخاصة في محاولة لإنقاذ الأمة، مما دهاها، وتقويم ما اعوج منها عندما استشرى الفساد، وتحكم السوط والسيف في الرقاب ولم يبق للحرية أثر.
(جـ) وخصوصًا بعد أن قام أول تجمع للصوفية في العهد الأول، كثورة على الترف، والاستعجام، والانحلال الذي غزا البيوت والأسواق. وحافظت عليه الطبقة «البرجوازية» كما نسميهم الآن، ومن ثم تعرض كل ناقد أو منذر «في الله» إلى ما لا يخطر بالبال من العدوان عليه، والمكر به، والتدبير له، والبطش بأعوانه، شأن عصور الدكتاتورية والقهر في كل أمة حتى اليوم.
(د) لهذا ولغيره، عدل الصوفية في كثير من أشعارهم وأناشيدهم وأحاديثهم إلى الرمز والإشارة، واستعمال المجاز والاستعارة، وربما إلى ما يشبه الإلغاز والتحجية.
أما فكرة الكبت والتنفيس، والتصعيد، تطبيقًا لنظرية «فرويد» فقد أثبت زملاء وتلاميذ هذا الفرويد اليهودي المنحل أنها نظرية غير مطردة، ولا غالبة، وقرروا جميعًا أن «فرويد نفسه، كان مشحونًا بالأزمات والعقد التي لم ينفع معها تصعيد ولا تنفيس، ولا تطبيق لشيء من نظريته الجنسية الفاجرة.
(هـ) ولو سلمنا بأن أقوال الصوفية، فيها نوع من التصعيد والتنفيس عن انفعالات حبهم لله ولرسوله، ولما يحب الله ورسوله، وفنائهم عن الكون بالمكون، وعن الأثر بالمؤثر، لكان تسربًا محمودًا، لطبيعة طيبة مكبوتة، في مستودع الحب الرباني المكنون، فتصبح عبادة أشبه بدعاء المضطر، الذي يناجي ويبتهل، تنفيسًا عما يجد، فيرق ويروق ويرق، حتى يكون أهلًا لاستجابة الدعاء، أليس كذلك؟
أما معاني المصطلحات، فتطلب من كتبهم، وخصوصًا ما كتبه فيها الشيخ ابن عجيبة، والشيخ علي وفا، ومن قبلهم وبعدهم.
***
السؤال الثالث
(س) ما رأيك فيما يقوله أبو حامد الغزالي من «أن العقل يعجز عن كشف أو معرفة الحقيقة اليقينية التي هي «الله» وأن القلب وحده هو القادر على ذلك بالكشف، إذا أخذت النفس بالطاعة والإخلاص، وربما استطاعت عين القلب أن ترى الله يقظة، وفي حال الصحو»؟
الجواب:
أما عن الجزء الأول من السؤال، فقد أجمع المسلمون على عجز العقل عن إدراك حقيقة الذات المقدسة، وذلك لأن العقل حادث والحادث لا يحيط بالقديم، ثم لأن العقل محدود، والمحدود يستحيل أن يحيط بغير المحدود، ثم لأن الإدراك أثر للتصور، وكل تصور بشري: مدموغ بالنقص. وتعالى الكامل أن يدركه الناقص، ومن هنا جاءت القاعدة الراشدة: (كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك) وجاء في الأثر: «تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في ذات الله»([2]).
أليس المنطق تعلم آلة من الآلات للاستعمال العقلي؟ فماذا ترى والقضية المنطقية بكل شروطها تثبت الأمر الواحد في ترتيب آخر، وهي هي، وهو هو؟! فعدم إدراك العقل للذات العلية، قضية مفروغ منها «عقلًا ونقلًا» ولذلك قالوا: «ترك الإدراك إدراك، والبحث في الذات كفر وإشراك».
وأما عن الجزء الثاني، وهو قدرة القلب على الكشف، باستصحاب الطاعة والتصفية والإخلاص، فلعل سر ذلك: أن الله تعالى جعل القلب مستودع الأسرار، وخزينة الانفعالات المتقابلة، ومستقر عجائب المعاني والغيوب، فالبصر للملك، والبصيرة للملكوت.
فمثلًا: القلب مستقر الإيمان ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾[الحجرات: 7]، وهو محل الألفة والحب ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾[الأنفال:63]، وهو محل الطمأنينة ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ﴾[الرعد:28]، وهو محل التمحيص ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾[آل عمران:154]، وهو محل السلامة ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾[الصافات:84]، وهو محل الذكرى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق:37]، وهو محل التقوى ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾[الحج:32]، وهو محل السكينة ﴿أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ﴾[الفتح:4]، وهو محل الرأفة والرحمة ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾[الحديد:27]، وهو الربط الإلهي ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾[الكهف:14]، وهو محل الوجل ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾[الأنفال:2]، وهو محل الخشوع ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ﴾[الحديد:16]، وهو محل الفقه ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾[الأعراف:179]...إلخ فهو هنا مشرق الأنوار، ومهبط الأسرار.
وفي المقابل نجد القلب محل الغل ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [الحشر:10]، وهو محل الزيغ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾[آل عمران:7]، وهو محل المرض ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا﴾ [البقرة:10]، وفي محل الغيظ ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾[التوبة:15]، وهو محل الريبة ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾[التوبة:45]، وهو محل الرين ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين:14]، وهو محل الامتحان ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾[الحجرات:2]، وهو محل الرعب ﴿سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾[الأنفال:12]، وهو محل العمى ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾[الحج:46]، وهو محل الإنغلاق ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:24]، وهو محل الفظاظة ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾[آل عمران:159]، وهو محل الخصومة ﴿وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ﴾[البقرة:204]، وهو محل الغفلة ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾[الكهف:28]، وهو محل الحمية ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ﴾[الفتح:26] ...إلخ. فهو هنا مجمع المكاره، وملتقى مساخط الله.
وهكذا، لن نستطيع تتبع وظائف القلب وحركاته، المردي منها والمرضي، مما يدل على أن القلب هو مستودع سر الله، ومستقر غيبه في الإنسان، ومن هنا جاء المعنى الدقيق في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾[التغابن:11]. وهداية القلب إلهام وتوجيه وأسرار وكشوف، وشهود، ومعارف، وسمو، وترق في معارج القرب لتحقيق معنى الهجرة إلى الله والفرار المطلوب منا إليه([3]).
ولعل مما يكشف بعض أسرار القلب، وكيف أنه خزينة النور الأقدس قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ=١٩٣- عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء:193 ، 194] فما أروع وما أبدع، وما أمتع (على قلبك) لا على شيء آخر!!
فلعل إمامنا الغزالي، وقد رأى القلب بهذه المنزلة، وتحقق من أنه الكوة الوحيدة التي تطل منها الروح على عوالم الغيب، ومساتير الخلق فلم يستبعد أن يهب الله عبدًا صالحًا صافيًا لحظة فيض ومدد، يأخذه فيها عن نفسه، ويشهده بفضله، حضرة قدسه ﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف:21] وللصوفية في ذلك مقولات شتى.
إن مشاكل السمعيات والغيبيات، وعجائب القضاء والقدر، ومعتقدات حكمة الخلق والأمر، وخفي أسرار العبادات، كل ذلك، لا يحل معضلاته إلا القلب، بعد أن أفلس العقل في هذا المجال وتوقف ولا زال، وسيظل كذلك.
ثم إن هذه من التجارب الصوفية التي لا مجال للتمنطق فيها، وإنما هي من الجوانب العملية، التي تثمر الأذواق والمواجيد، وتتجاوب في آفاقها الأشواق، فلا يدركها تعبير، ولا يلحقها تصور.
وعلى كل، فهي من المذاهب الفرعية، التي من شاء قبلها ومن لم يشأ رفضها: ما لم يجرب، وكلاهما مقدور، ولعله مأجور.
***
السؤال الرابع
لماذا نشأ الصراع، واشتد بين بعض الفقهاء والصوفية!؟ ولماذا يصر بعضهم على تكفير الصوفية، كابن تيمية؟
الجواب:
الصراع بين العلماء قديم، والأسباب شتى، حتى بين علماء المذهب الواحد. فكيف إذا اختلفت المذاهب والتهبت الحميَّة، وتسلَّطت النعرة العصبية، ونفخ الشيطان أو نزغ بين الإخوة، وقد رأى بعضه الفقهاء أن الصوفية يزاحمونهم السيادة والزعامة، وأنهم بأساليبهم الروحية، وما استُودعوه من الرقة، والأدب، والمعرفة، والمكارم، والتسامي، والترفُّع يجتمع عليهم الناس، فيجدون عندهم راحة القلب والعقل، وسعادة الروح والباطن، وعلاج ما استعصى على الناس علاجه من عقد النفوس والأزمات، على ارتباطٍ مريح بالله، وثقة بالغة فيه، وفقه تام بدينه.
كل هذا بالإضافة إلى ما عند الفقهاء من بضاعة العلم المجرد، والتسلط، ودعوى احتكار الصواب.
هذا في الأصل.
ويلي ذلك: ضيقُ بعض الفقهاء بما لم يحيطوا بعلمه، ولمَّا يأتهم تأويله، من قواعد الصوفية، وخصائص دعوتهم، والتزام هؤلاء الفقهاء بالوقوف على الشاطئ، بينما سبح أولئك إلى الأعماق، ومترامي الأبعاد. ثم دب بعد هذا في التصوف دبيب الدسيس والدخيل، والمبتدع والمستنكر، فوجد الفقهاء وأشباهم الفرصة سانحة للهجوم، لا على الدخيل والدسيس، لتنقية هذا النبع الطيب مما شابه، ولكنهم هاجموا النبع جميعا بما شابه، والنبع لا ذنب له -كما رأيت في جوابي على سؤالك الأول-، ومؤخذاة النبع مما داخله: ظلم وتعسف.
وهنا لابد من كلمة إنصاف لابن تميمة؛ فإن الناس نظروا إلى حملته على نوع التصوف الذي رجح وجوب الحملة عليه، وتركوا – ظلما – ما نعت به ابن تيمية التصوف الصادق، والصوفية الصادقين من كرائم النعوت، ونوادر الخصائص.
راجع ما كتبه في (الفتاوى الكبرى) بالجزء الحادي عشر: في الصحيفة السابعة عشرة وكيف وصف الصوفية الأبرار بأنهم من (أجَلّ الصديقين وأنهم أكمل صديقي زمانهم)...إلخ.
وفي (العقيدة الواسطية) لابن تيمية أيضا - قبيل نهايتها - كلام عظيم جدًا عن التصوف الحق والولاية، وله كلام عظيم جدا في حقيقة الفناء الصوفي يعتبره الصوفية تأييدًا وتشييدًا لمذهبهم المتين.
وفي (ثبت)([4]) ابن تيمية، نسبته الروحية إلى الإمام الجليل الشيخ (عبد القادر الجيلاني) بجوار نسبته العلمية؛ فقد كان الجيلاني من أئمة الحنابلة, الذين يتصل بهم النسب العلمي لابن تيمية، وقد سبق أن سجلناه في بعض ما كتبناه (بالمسلم).
وهنا مَلْحَظ دقيق جدا هو: أنك لا تجد أبدا في كل ما هاجم به ابن تيمية من سبقه من أئمة الصوفية، لا تجد إطلاقا أي ذكر لشيخه الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو القطب الصوفي الكبير وحسبك يا ولدي أن تعرف – كما قدمت لك – أن الإمام ابن القيم، توفر على شرح كتاب الإمام الهروي، الصوفي العظيم، وأقره، إلا فيما لا يكاد يذكر من بعض الأحكام والمواطن التي خالفه فيها، فقد كان في شرحه صوفيًا أكثر من الصوفية، بل إنك تجد في كثير من كتب ابن القيم تصوفا واضحا وبخاصة في كتاب (الروح) وكتابه (الجواب الكافي) وغيرهما، وتستطيع أن تقول: أن ابن تيمية، وابن القيم تلميذه، رجل واحد، له اسمان مختلفان، وهما على أكثر الوجوه صوفيان.
وفي المناظرة بين ابن عطاء الله وابن تيمية يعترف ابن تيمية بالتصوف السليم اعترافا مطلقا، ويقرر أنه لا يهاجم إلا ما ترجح عنده خطؤه أو انحرافه.
وعلى كل فقد مضت كل هذه القرون، وخصوم التصوف ينطحون صخرته الرابضة على مداخل الحق، فلم تتغير حقيقته ولم تضعف دعوته - رغم ما لا يزال ينخر في جسمه من أمراض البدع والمناكر والمستكرهات - وسوف يبقى التصوف الحق لواء مرفوعا فوق كل الألوية تتهاوى ولا يهوى، ويتعاوى أهلوها من حوله، وهو لا يعوي، ولا يلوي، ولا يذوي، وتبيد الدنيا ولا يبيد وأحب أن تتأكد يا ولدي، أنني أحترم ابن تيمية، وأذكر له مواقفة الطيبة من حروب الصليبين والتتار، وربما أخذت ببعض آرائه الفقهية برغم حملته على الصوفية بعامة، وبرغم حملتي على كثير مما نقل عنه في هذا الباب، وما يتعلق به، فالخصومة هنا لله وحده، فهي خصومة علم وشرف.
***
السؤال الخامس
لماذا جاءت كتب الصوفية ومؤلفاتهم منذ القرن الثامن الهجري: خالية من الابتكار؟ مقتصرة على الشرح والتفسير؟
الجواب:
يا ولدي: (دفعُ المضراّت، مقدم على جلب المنافع) وهؤلاء إنما كانوا في موقف المدافع أمام حملات الخصوم التي لم تفتر، ولن تفتر.
ثم ماذا تريد بالابتكار؟ التصوف دين: (كتاب، وسنة) وهم قد بيَّنوا وأوضحوا، فلم يبق مجال لجديد في البيان والإيضاح والبلاغ على أسالبيهم، ولم يبق إلا التجديد في العرض، والدعوة - وذلك ماض بحمد الله - فما أكثر ما كتب ويكتب وسيكتب في التصوف: ما له وعليه إلى يوم القيامة.
ولو كان التصوف ميتًا، ما هاجموه، فالموتى لا يهاجموا أحد، ولو كان ضعيفا لأشفقوا عليه، أو لما اهتموا به؛ فالضعيف لا يهم أحدا، ولا يعني به أحد فكل ما تراه الآن حول التصوف هو: البرهان - الذي لا يدفع – على حياته وقوته، وبالتالي على خلوده وسطوته، وعلى أنه الحق – والحق أحق أن يتبع.
أما دخيله ودسيسه، فهو شيء آخر، وله حكم آخر.
([2]) وورد: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». (رواه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط، وابن عدي، والبيهقي في شعب الإيمان).
 الرئيسة
الرئيسة