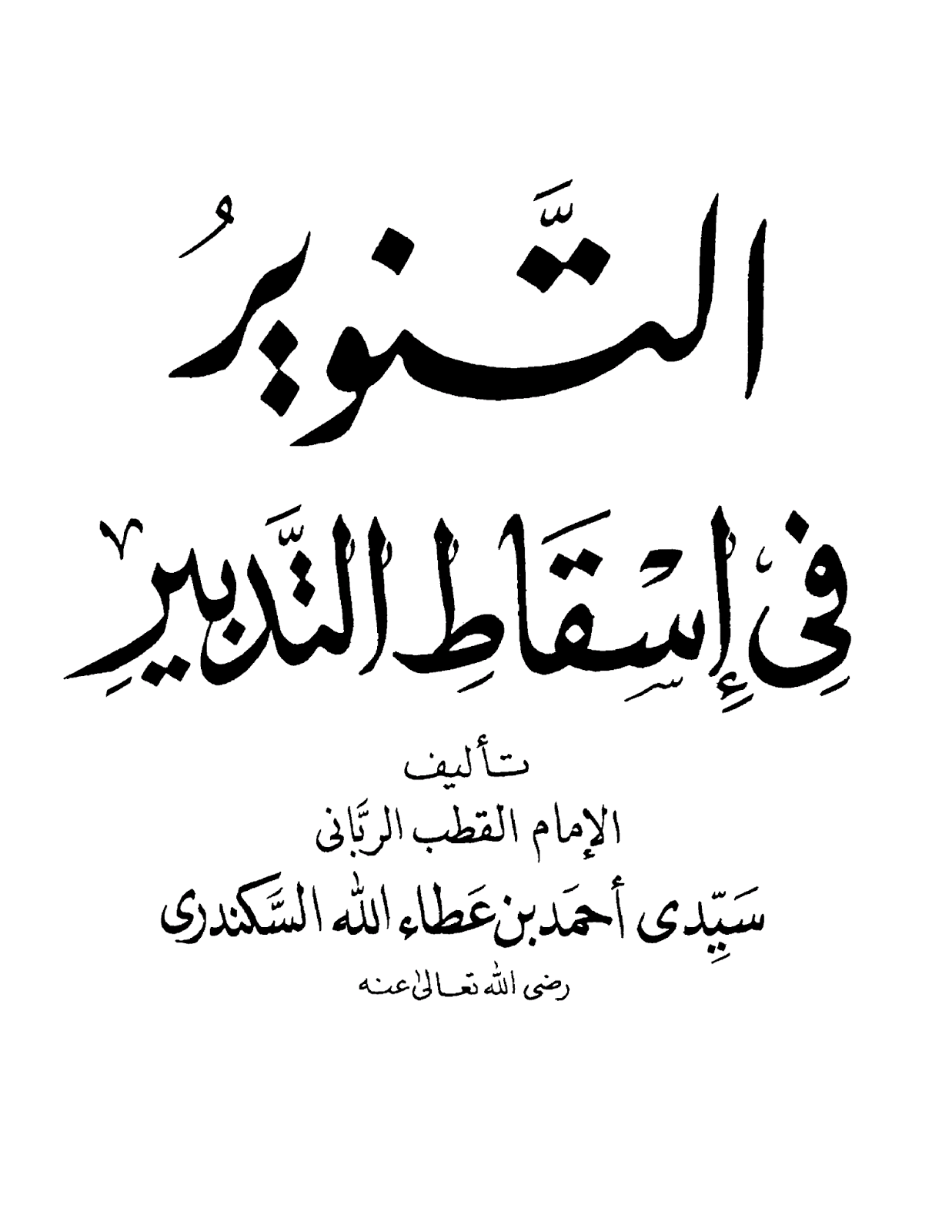مقدمة اللهم إنَّا نضرع إليك، ونهرول نحوك، ونجاهد نفوسنا في خدمتك وطاعتك، ونركب الصراط القويم الذي رسمته لنا إلى مرضاتك؛ فقونا بقوتك، وأعزنا بعزتك، واحفظنا بقدرتك، وألهمنا رشدك وتوفيقك، وبَلِّغْنَا الدرجة العليا، وارحمنا برحمتك التي وسعت بها كل شيء علمًا. وامنحنا اللهم برك وجودك، وإحسانك وإنعامك، واجعلنا من القاصدين إليك، ومن المتوكلين عليك، ومن الدَّاعين بدعوتك، والسالكين صراطَكَ المستقيمَ؛ صراطَ الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. اللهم لك الحمد حمدًا يوافي نعمك، ويليق بكمالك، ونسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير أحبابك، وخاصة أنبيائك، عبدك ونبيك، وخيرتك من خلقك ورسولك، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فكان -صلوات الله عليه- للعالمين رحمة، وبالمؤمنين رءوفًا، صلَّى الله عليه، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزَّرُوه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، فسلكوا طريقه، وَكَرَعُوا من بحر شريعته وحقيقته، حتى صاروا بصفائهم وخوفهم من مولاهم في أمن وسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي خَلَعَ على أوليائه خِلَعَ إنعامه، فهم بذلك له حامدون، واختصهم بمحبته وأقامهم في خدمته، فهم على صلاتهم يحافظون، ودعاهم إلى حضرته، وأظهر فيها مراتبهم؛ فالسابقون السابقون أولئك المقربون، وفتح لهم أبواب حضرته، ورفع عن قلوبهم حجاب بعده؛ فهم بين يديه متأدبون، ولاطفهم بوده، وَأَمَّنَهُم من إعراضه وصده، ألا إنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونَوَّرَ بصائرهم بفضله، وطهر سرائرهم، وأطلعهم على السر المصون، وصانهم عن الأغيار، وسترهم عن أعين الفُجَّارِ؛ لأنَّهم عرائسُ، ولا يرى العرائسَ المجرمون، فإذا مرَّ عليهم ولي من أولياء الله ينسُبونه إلى الزندقة والجنون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فمنهم المنكر لكراماتهم، ومنهم المنقص لمقاماتهم، ومنهم الثالب لأعراضهم، ومنهم المعترضون يعترضون على أحوالهم، ويخوضون بجهلهم في مقالهم، وبهم يستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فسبحان من قرب أقوامًا واصطفاهم لخدمته؛ فهم على بابه لا يبرحون. وسبحان من جعلهم نجومًا في سماء الولاية، وجعل أهل الأرض بهم يهتدون. وسبحان من أباحهم حضرة قربه، والمنكرون عليهم عنها مبعدون، فالأولياء في جنة القرب متنعمون، والمنكرون في نار الطرد والبعد معذبون، لا يُسْأَلُ عَمَّا يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة شهد بها المؤمنون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا > عبده ورسوله، النور المخزون، والسرُّ المصون، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وصحبهم أجمعين([1]). وبعد: فيقول -صلوات الله وسلامه عليه- فيما رواه البخاري ومسلم: «ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». ويقول أيضًا فيما رواه البخاري: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». ويقول الفقيه العالم ابن عابدين في «حاشيته»: «إنَّ علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء -فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس: كالكبر، والشح، والحقد، والغش، والغضب، والعداوة، والبغضاء، والطمع، والبخل، والبطر، والخيلاء، والخيانة، والمداهنة، والاستكبار عن الحق، والمكر، والمخادعة، والقسوة، وطول الأمل، ونحوها مما هو مُبَيَّنٌ في ربع المهلكات من «الإحياء». قال فيه: «ولا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجًا إليه»([2]). اهـ. ويقول صاحب «الهدية العلائية» أيضًا: «وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم: الحسد، واحتقار المسلمين، وإرادة المكروه بهم، والكبر، والعجب، والرياء، والنفاق، وجملة الخبائث من أعمال القلوب، بل السمع، والبصر، والفؤاد، كل ذلك كان عنه مسئولًا، مِمَّا يدخل تحت الاختبار»([3]). أما صاحب «مراقي الفلاح» فإنَّه يقول: «لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص، والنزاهة عن: الغل، والغش، والحقد، والحسد، وتطهير القلب عَمَّا سوى الله من الكونين؛ فيعبده لذاته لا لعلة، مفتقرًا إليه، وهو يتفضل بالمنِّ لقضاء حوائجه المضطر بها عطفًا عليه، فتكون عبدًا فردًا للمالك الأحد الفرد، لا يسترقك شيء من الأشياء سواه، ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه». اهـ. ها هي نصوص وآثار، تبين بحق أنَّ صلاح القلب صلاح للجسد، وفساد القلب فساد للجسد، وأنَّ ذكر الله تعالى -يعني: قول لا إله إلا الله- أعلى شعب الإيمان، وأن العجب، والحسد، والرياء، والكبر، والشح، والحقد، والغش، والغضب، والعداوة... إلخ -من الخصال الممقوتة، والخبائث المحرمة التي نهى الله عنها، وأمرنا باجتنابها، وجهاد النفس من أجلها، وتنقية القلب من أوضارها. بيد أنَّ الطهارة الظاهرة لا تنفع إلا مع الطهارة الباطنة، وأنَّ الطهارة الباطنة لا تكون إلا بالإخلاص، والنزاهة عن: الغل، والغش، والحقد، والحسد، وتطهير القلب عما سوى الله تعالى. ذلك أنَّ الاجماع ونصوص الشرع الحكيم تظاهرت على تحريم الحسد، واحتقار المسلمين... إلخ. ولما كان علم التصوف هو العلم الذي اختص بمعالجة هذه الأمراض القلبية والتخلص منها، وتزكية النفس؛ لما كان علم التصوف كذلك، بل لما كان علم التصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي، فضلًا عما يقابله من العبادات البدنية والمالية الأخرى -آثرنا أن يكون عملنا الذي نبتغي به وجه الحق سبحانه، إبراز أحد كنوز عَلَمٍ من أعلام التصوف الذي يعالج ذلك كله. هذا الكنز الذي جمع بين علمي الشريعة والحقيقة، والذي يعد بحق دليلًا واضحًا للحائرين، ومنهجًا قويمًا للسالكين، ودربًا واسعًا يسير فيه العارفون بالله رب العالمين، هو كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» الذي يقول الشيخ ابن عباد في وصفه، وفي وصف «الحكم العطائية»: «...وهما أخوان من أب واحد وأم واحدة». اهـ. والذي قال عنه ابن عَجِيْبَة حينما أراد أن يتحدث عن ابن عطاء الله وعدم تدبيره: «...وقد ألف الشيخ } فيه كتابًا سماه «التنوير في إسقاط التدبير» أحسن فيه وأجاد». اهـ. وكتاب «التنوير» الذي بين أيدينا انفرد بهذا الإعجاب حتى افتتن به الكثير من رجال القلوب والبصائر، وأسلموا قيادهم لله سبحانه بسبب ما كشف لهم فيه عن غوامض سر عدم تدبيرهم، وسقوط اختيارهم؛ وذلك لما اشتمل عليه من فوائد مفيدة في التوجيه والإرشاد إلى التسليم، وعدم منازعة المقادير، والتزام الخلق بإسقاط التدبير مع الخالق. من هذه الفوائد المفيدة التي أوضحت مفهوم التدبير الذي قصد إليه الكتاب، والذي نؤيده عن إقناع: «اعلم أنَّ الأشياء إنَّما تذم وتمدح بما تؤدي إليه؛ فالتدبير المذموم: ما شغلك عن الله، وعطلك عن القيام بخدمة الله، وصدك عن معاملة الله؛ والتدبير المحمود: هو الذي يؤديك إلى القرب من الله، ويوصللك إلى مرضاته». اهـ. ولم يقف ابن عطاء الله عند هذا الحد، بل إنَّه استفاض في وضوح التباين بين التوكل والتواكل، فعاب على التواكل وحذر منه، ورَغَّبَ في العمل وحث عليه، انظر إليه وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الدنيا»، يقول: أي: التي توصلكم إلى طاعة الله؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «فنعمت مطية الدنيا». فمدحها من حيث كونها مطية، لا من حيث إنها دار اغترار، وإذ قد علمت هذا فقد فهمت أن إسقاط التدبير ليس هو الخروج عن الأسباب حتى يعود الإنسان ضيعة فيكون كَلًّا على الناس، فيجهل حكمة الله في إثبات الأسباب، وارتباط الوسائط، وقد جاء عن عيسى — أنه مَرَّ بمُتَعَبِّدٍ فقال له: «من أين تأكل؟»، فقال: «أخي يطعمني»، فقال:«أخوك أعبد منك»؛ أي: أخوك وإن كان في سوقه أعبد منك؛ لأنه هو الذي أعانك على الطاعة وفرغك لها، وكيف يمكن أن ينكر الدخول في الأسباب بعد أن جاء قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾([4])، وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾([5])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أحل ما أكل المرء من كسب يمينه، وإنَّ داود نبي الله كان يأكل من كسب يمينه»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أفضل الكسب عمل الصانع بيده إذا نصح». وقال صلى الله عليه وسلم: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة». فكيف يمكن أحد بعد هذا أن يذم الأسباب؟! لكن المذموم منها ما شغلك عن الله وصدك عن معاملته». اهـ. هذا وقد اتسع حرص صاحب «التنوير» على الأخذ بالأسباب والحث على العمل فقال: «إنَّ في الأسباب صيانة للوجوه عن الابتذال بالسؤال، وحفظًا لبهجة الإيمان أن تزول بالطلب عن الخلق، فما يعطيك الله من الأسباب فلا منة فيه لمخلوق عليك؛ إذ لا يَمُنُّ عليك أحد إن اشترى منك أو استأجرك على عمل شيء؛ فإنَّه في حظ نفسه سعى، ونفع نفسه قَصَدَ، فالسبب أخذ منه بغير منة». اهـ. وقبل أن أنهي القول أقول: إنَّ معنى التدبير الذي عناه صاحب التنوير هو: تدبير الدنيا للدنيا، ومعنى ذلك أن يدبر الإنسان في أسباب جمعها افتخارًا بها واستكثارًا، وكلما ازداد فيها شيئًا ازداد غفلة واغترارًا. أما تدبير الدنيا للآخرة -كأن يدبر الإنسان المتاجر والمكاسب والغراسات؛ ليأكل منها حلالًا ولينعم بها على ذوي الفاقة أفضالًا، وليصون بها وجهه عن الناس إجمالًا- فذلك هو التدبير المحمود الذي يحبه الله ورسوله، وحثَّ عليه ابن عطاء الله في كتابه الذي نحن بصدده. ومهما يكن من شيء فحسب ما جاء في كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» تأييدًا قول الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-: «إنَّ الله جعل الروح والراحة في الرضا واليقين»، وقول أحمد بن مسروق: «من ترك التدبير فهو في راحة»، وقول سيدي أبي الحسن الشاذِلِي رضى الله عنه: «لا تختر من أمرك شيئًا، واختر ألَّا تختار، وفِرَّ من ذلك المختار، ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله تعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار». اهـ. وقول سهل بن عبد الله: «ذروا التدبير والاختيار؛ فإنهما يكدران على الناس عيشهم». أما الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضى الله عنه؛ فله في هذا المعنى كلام نفيس أيضًا يقول فيه: «من لم يكن في دعائه تاركًا لاختياره، راضيًا باختيار الحق تعالى له -فهو مستدرج، وهو ممن قيل فيه: اقضوا حاجته؛ فإني أكره أن أسمع صوته، فإن كان مع اختيار الله تعالى لا مع اختياره لنفسه -كان مجابًا وإن لم يُعْطَ، والأعمال بخواتيمها». اهـ. ها هو كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» الذي اخترنا إبرازه في صورة واضحة؛ لما له من أهمية يَعْجِزُ الوصف عن توضيحها، ذلك لما احتوى عليه من تنوير الأذهان، وتهذيب النفوس، وتوطين القلوب على الإذعان لله، والتسليم لأحكامه، وإسقاط التدبير في أي شيء معه سبحانه، وعدم منازعة مقاديره تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾([6]). أما العلم العامل، الولي الزاهد العارف، القطب الشهير الواصل، الذي عرف ربه فهرول إليه، ورغب الحق -سبحانه وتعالى- فأعرض عن كل شيء دونه، إنه العلم التقي الصافي الذي عرف مولاه فَجَدَّ وشَدَّ المئزر في خدمته سبحانه، لا لشيء سوى مشاهدته، حتى فني من أجله في ذاته لا عن ذاته، وشاهد بعين البصيرة جلاله سبحانه. ذلك العلم الوَضَّاء، والقبس المضيء في سماء الولاية، هو الشيخ الإمام تاج الدين، وترجمان العارفين، أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله، الجذامي نسبًا، المالكي مذهبًا، الإسكندري دارًا، القاهري مزارًا، الصوفي حقيقة، الشاذِلي طريقة، أعجوبة زمانه، ونخبة عصره وأوانه، المتوفى في جُمادى الآخرة سنة تسع وسبعمئة. أما مكانة مؤلف «التنوير في إسقاط التدبير» العلمية فإنَّ صاحب «الديباج المذهب» يقول: «كان جامعًا لأنواع العلوم، من: تفسير، وحديث، وفقه، ونحو، وأصول، وغير ذلك، كان -رحمه الله- متكلمًا على طريق أهل التصوف، واعظًا انتفع به خلق كثير وسلكوا طريقه». اهـ. ومما يؤيد مكانة ابن عطاء الله السكندري العلمية على نحو ما ذكر صاحب «الديباج»، أنَّ شيخه أبا العباس المرسي رضي الله عنهما، شهد له بالتقديم، كما ذكر في كتاب «لطائف المنن» قائلًا: قال لي الشيخ: «الزم، فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيًا في المذهبين، يريد مذهب أهل الشريعة (أهل العلم الظاهر)، ومذهب أهل الحقيقة (أهل العلم الباطن)». اهـ. وقال فيه أيضًا: «والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيًا يدعو إلى الله». اهـ. وقال فيه كذلك: «والله ليكونن لك شأن عظيم، والله ليكونن لك شأن عظيم، قال: فكان بحمد الله ما لا أنكره». اهـ. وازدادت مكانة ابن عطاء الله العلمية، وقوي شأنه، حتى أَلَّفَ من الكتب ما يعد قمة في التصوف، ومرجعًا لمن قصد الأخذ منه، والاستدلال به. وله في هذا الفن مؤلفات مشهورة، حازت السبق في ميدان العلماء، والتقدير الفائق من المحققين، والإعجاب الفذ من الأدباء. حينما عقدنا العزم، وصَمَّمْنَا الإرادة على تحقيق هذا الكتاب النفيس، وإبرازه في صورة طيبة، ووضوح واضح لأصحاب الحال والقال خاصة، وللشغوفين بأعمال القلوب والجوارح عامة، حينما اعتزمنا ذلك أخلصنا النية، وَوَجَّهْنَا القلب إلى العلي الأعلى: أن يهبنا التوفيق والسداد، وأن يمنحنا النجاح والرشاد، وأن يُتِمَّ علينا نعمته الكبرى، ويبسط يده ليأخذ بأيدينا في إنجاز هذا العمل الجاد الذي لن يتحقق إلا لمن ذاق فعرف، وشاهد فوصل. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ فقد قمنا بالبحث والتنقيب في دور الكتب والمكتبات، نبحث عن الأصول المخطوطة، وننقب عن النسخ الدقيقة، وبعد جهد وزمن وصلنا -بفضل الله تعالى- إلى ما أحببنا أن نصبو إليه؛ فوجدنا مخطوطات عدة: بدار الكتب بالقاهرة، ومكتبة الأزهر، ومكتبة سيدي أحمد البدوي رضى الله عنه. وبعد، فإنَّنا نقدم هذا الكنز الثمين، ونحن نضرع إلى الله العلي القدير أن يجعله عملًا خالصًا ابتغاء وجهه سبحانه، وأن ينفع به، وأن يقدر له الخير والعمل به، وأن يجازي مؤلفه الجزاء المشكور عنده؛ إنَّه سميع مجيب، وهو حسبنا، عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. [قال الشيخ الإمام العارف القدوة المحقق، تاج العارفين، لسان المتكلمين، إمام وقته، وأوحد عصره، حجة السلف، وإمام الخلف، قدوة السالكين، وحجة المتقين، تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا به، ونفع به كافة المسلمين، إنَّه سميع قريب مجيب](*): الحمد لله المنفرد بالحق والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملك([7]) [الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير]([8])، ليس له في ملكه وزير. المالك: الذي لا يخرج عن ملكه كبير ولا صغير. المُقَدَّسِ: في كمال وصفه عن الشبيه والنظير. المُنَزَّهِ: عن كمال ذاته عن التمثيل والتصوير. العليم: الذي لا يخفى عليه ما في الضمير. ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ﴾([9]). العالم: الذي أحاط علمه بمبادئ الأمور ونهاياتها([10]). السميع: الذي لا فضل في سمعه بين جهر الأصوات وإخفاتها. الرزاق: وهو المنعم على الخليقة بإيصال([11]) أقواتها. القيوم: وهو المتكفل بها في جميع حالاتها. الواهب: وهو الذي مَنَّ على النفوس بوجود حياتها. القدير: وهو المعيد لها بعد وجود وفاتها. الحسيب: وهو المجازي لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها، فسبحانه من إله مَنَّ على العباد بالجود قبل الوجود، وقام لهم بأرزاقهم مع كلتا([12]) حالتيهم من إقرار وجحود، وأمدَّ كل موجود بوجود عطائه، وحفظ وجوده وجود العالم بإمداد بقائه، وظهر بحكمته في أرضه، وبقدرته في سمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مفوض لقضائه، مستسلم له في حكمه وإمضائه. وأشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المفضل على جميع أنبيائه، المخصوص بجزيل فضله وعطائه، الفاتح الخاتم، وليس ذلك لسوائه، الشافع في كل العباد حتى يجمعهم الحق لفصل قضائه، صلى الله عليه وعلى سائر أنبيائه، وعلى آله وصحبه المستمسكين بولائه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: اعلم يا أخي([13]) جعلك الله من أهل حبه، وأتحفك بوجود قربه، وأذاقك من شراب أهل وُده، وأَمَّنَكَ بدوام وصلته من إعراضه وصدِّه، ووصلك بعباده الذين خصهم بمراسلاته، وجَبَرَ كسر قلوبهم لما علموا أنَّه لا تدركه الأبصار بأنوار تجلياته، وفتح رياض القرب، وأهب منها على قلوبهم واردات نفحاته، وأشهدهم سابق تدبيره فيهم؛ فسلموا إليه القياد، وكشف لهم([14]) عن خفي لطفه في صنعه، فخرجوا عن المنازعة والعناد؛ فهم مستسلمون إليه، ومتوكلون في كل الأمور عليه؛ علمًا منهم أنه لا يصل عبد([15]) إلى الرضا إلا بالرضا، ولا يبلغ إلى صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى القضا؛ فلم تطرقهم الأغيار، ولم ترد عليهم الأكدار، كما قال قائلهم:
تجري عليهم أحكامه، وهم لجلاله خامدون، ولحكمه مستسلمون كما قال: وإنَّ مَنْ طلب الوصول إلى الله تعالى فحقيق عليه أن يأتي الأمر من بابه، وأن يتوصل إليه بوجود أسبابه. وأهم ما ينبغي([16]) تركه والخروج عنه والتطهر منه: وجود التدبير، ومنازعة التقدير؛ فصنفت هذا الكتاب مُبَيِّنًا لذلك، ومظهرًا لما هنالك. وسميته: «التنوير في إسقاط التدبير»؛ ليكون اسمه موافقًا لمسماه، ولفظه مطابقًا لمعناه. واللهَ([17]) أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يَتَقَبَّلَهُ بفضله العميم، وأن ينفع به الخاصَّ والعامَّ، بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إنَّه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.
(*) ما بين القوسين من «فروينه»، وكلام المؤلف يبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنفرد بالحق...». ([7]) وفي نسخة (1): المالك.
مكانته العلمية:
مع «التنوير في إسقاط التدبير»:
لا تهتدي نُوَبُ الزمان إليهم
*
ولهم على الخَطْبِ الشديد لجام
تجري عليك صروفه
*
وهموم سِرِّكَ مطرقهْ
التسليم وعدم التدبير
 الرئيسة
الرئيسة