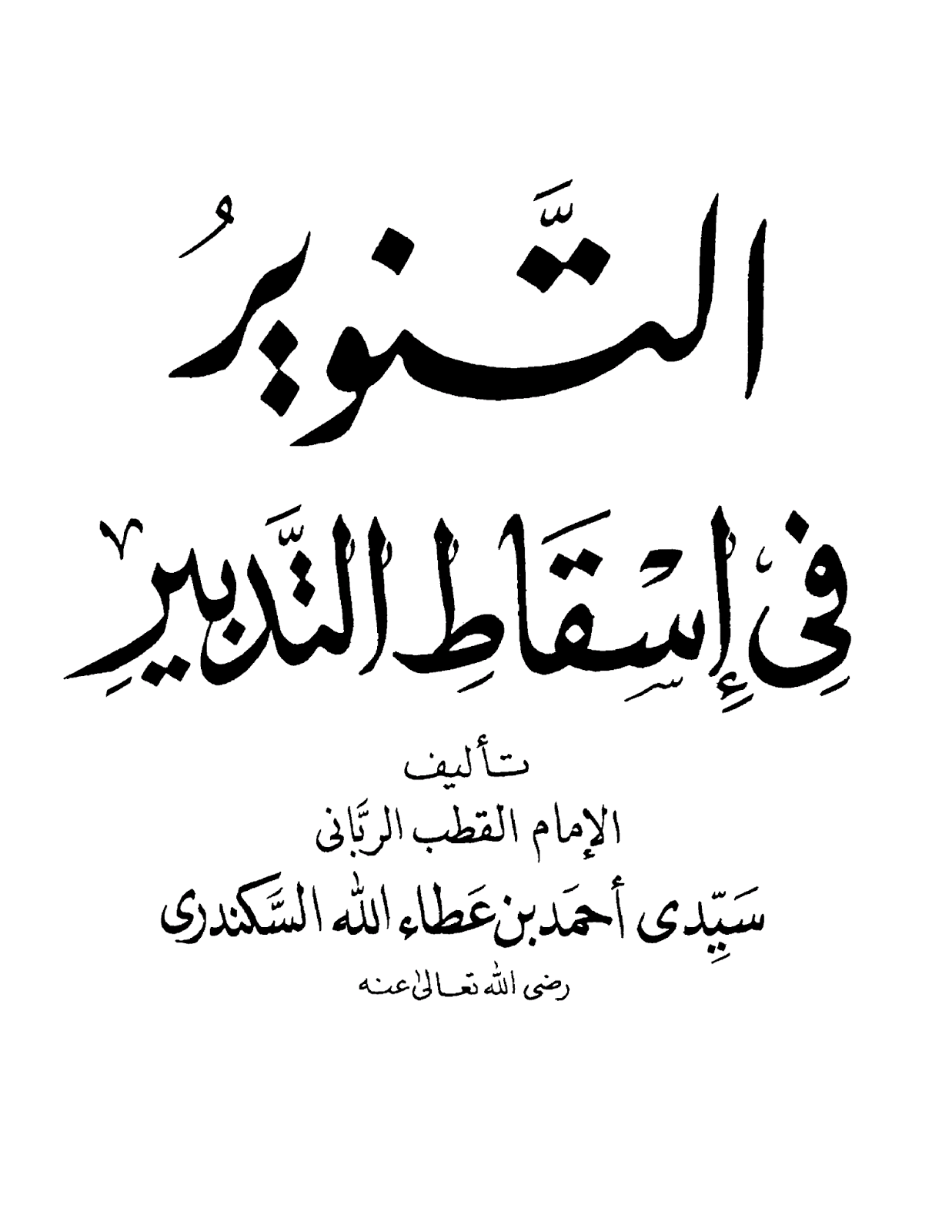ضمان الله للعباد
ضمان الله للعباد(*)
انعطاف: لما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾([1])، علم -سبحانه وتعالى- أن لهم بشريات تطالبهم بمقتضاها، تشوش عليهم صدق التوجه إلى العبودية؛ فضمن لهم الرزق كي يتفرغوا لخدمته، وكي لا يشتغلوا بطلبه عن عبادته، فقال: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ [الذاريات: 56]؛ أي: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم، فقد كفيتهم ذلك بحسن كفايتي وبوجود ضماني.
﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾([2]) لأني أنا القوي الصمد الذي لا يطعم، ولذلك عقبه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ﴾([3])، أي: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم لأني أنا ذو القوة، ومَنْ له القوة في ذاته غني عن أن يطعم.
فتضمت هذه الآية الضمان للعباد بوجود أرزاقهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾، وألزم المؤمنين أن يوحدوه في رزقه، وألَّا يضيفوا شيئًا منه إلى خلقه، وألَّا يضيفوا ذلك إلى أسبابهم، وألَّا يسندوه إلى اكتسابهم، وقد قال الراوي: أصبح رسول الله > في إثر سماء كانت من الليل، فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟».
قلنا: لا يا رسول الله. قال: «قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مُطِرْنَا بفضل الله وبرحمته؛ فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بِنَوْءِ كذا أو بنجم كذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب([4])». اهـ.
ففي هذا الحديث فائدة عظمى للمؤمنين، وبصيرة كبرى للموقنين، وتعليم الأدب مع رب العالمين.
ولعل هذا الحديث يكون -أيها المؤمن- ناهيًا له([5]) عن التعرض إلى عالم الكواكب واقتراناتها، ومانعًا لك أن تدعي وجود تأثيراتها.
واعلم أنَّ لله تعالى فيك قضاء لا بد أن ينفذه، وحكمًا لا بد أن يظهره؛ فما فائدة التجسس على علم علام الغيوب، وقد نهانا سبحانه أن نتجسس على عباده فقال: «ولا تجسسوا»! فكيف لنا أن نتجسس على غيبه! ولقد أحسن من قال([6]):
| خبرا عني المنجم أني |
* | كافر بالذي قضته الكواكب |
| عالم أن يكون وما كا |
* | ن قضاء من المهيمن واجب |
فائدة: اعلم أنَّ مجيء هذه الصيغة على بقاء «فَعَّالٌ» يقتضي المبالغة فيما سيقت له؛ فرزاق أبلغ من رازق لأن «فَعَّال» في باب المبالغة أبلغ من فاعل، فيمكن أن تكون هذه المبالغة لتعداد أعيان المرزوقين، ويمكن أن تكون لتعداد الرزق، ويحتمل أن يكون المراد هُمَا جميعًا.
فائدة أخرى ترجع إلى علم البيان: اعلم أنَّ الدلالة على المعنى المقصود به وجود الثناء بالصفة أبلغ من الدلالة عليه بالفعل.
فقولك: «زيد محسن» أبلغ من قولك: «زيد يحسن» أو «قد أحسن»؛ وذلك لأنَّ الصفة تدل على الثبوت والاستقرار، والأفعال أصل وضعها التجدد والانقراض؛ فلذلك([7]) كان قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ أبلغ من قوله: «إن الله هو يرزق»، ولو قال: إن الله هو يرزق لم يفد إلا إثبات الرزق له، ولم يفد حصر ذلك فيه، فلما قال: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ أفاد ذلك انحصار الرزق فيه، فكأنه لما قال: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ فقد قال: لا رازق إلا الله.
([4]) حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»، قالوا: «الله ورسوله أعلم»، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»، وقد علق الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله على هذ الحديث تعليقًا نفيسًا يقول فيه: «النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب؛ فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءًا؛ أي: سقط وغاب، وقيل: أي نهض وطلع، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما». اهـ.
اقتران الخلق والرزق
 الرئيسة
الرئيسة