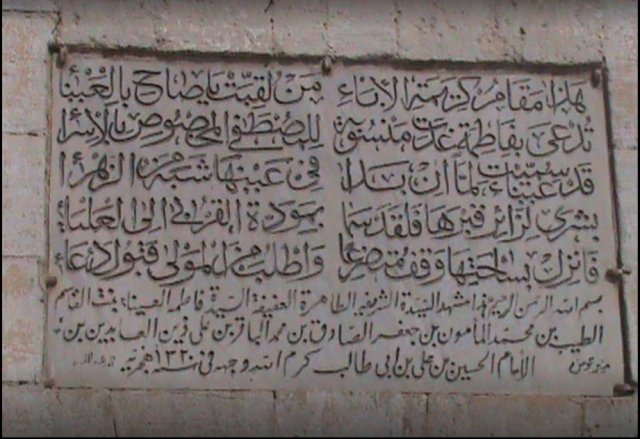(الباب الخامس والأربعون في ذكر فضل قيام الليل)
قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأنفال: 11]. نزلت هذه الآية في المسلمين يوم بدر، حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى، وغلبوهم عليها، وأصبح المسلمون بين محدث وجنب، وأصابهم الظمأ فوسوس لهم الشيطان: إنكم تزعمون أنكم على الحق، وفيكم نبي الله، وقد غلب المشركون على الماء، وأنتم تصلون محدثين ومجنبين، فكيف ترجون الظفر عليهم؟ فأنزل الله تعالى مطرًا من السماء سال منه الوادي، فشرب المسلمون منه، واغتسلوا وتوضئوا وسقوا الدواب، وملئوا الأسقية، ولبَّد الأرض حتى ثبت به الأقدام.
قال الله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾ [الأنفال: 11، 12]. أمدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا المشركين، ولكل آية من القرآن ظهر وبطن وحد ومطلع، والله تعالى كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة في تلك الواقعة والحادثة، فهو رحمة تعم المؤمنين، والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين، وهو أمنة لقلوبهم من منازعات النفس؛ لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب؛ إذ في شكايتها وتعبها تكدير القلب، وباحترامها بالنوم -بشرط العلم والاعتدال- راحة القلب؛ لما بين القلب والنفس من المواطأة عند طمأنينتها للمريدين السالكين.
فقد قيل: ينبغي أن يكون ثلث الليل والنهار نومًا حتى لا يضطرب الجسد، فيكون ثمان ساعات للنوم، ساعتين من ذلك يجعلهما المريد بالليل ويزيد في أحدهما، وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث، ولا يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة، وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس؛ فإن النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في المزاج، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ، ويخشى منه اضطراب الجسم، فإذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لا يضر نقصانه؛ لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم، وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح فتصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالقصيرة، كما يقال: سَنَة الوصل سِنَة، وسِنَة الهجر سَنَة، فيقصر الليل لأهل الروح.
(نقل) عن علي بن بكار أنه قال: منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط؛ يريني وجهه ثم ينصرف، وما تأملته. وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في لهوهم. وقال بعضهم: ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة، ثواب عاجل لأهل الليل.
(وقال) بعض العارفين: إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملؤها نورًا، فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير، ثم تنتشر من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين. وقد ورد أن الله تعالى أوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه: إن لي عبادًا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إليَّ وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، وينظرون إليَّ وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقتك، قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلام بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جَنَّهم الليل واختلط الظلام، وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم، وافترشوا لي وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملقوا إليَّ بإنعامي، فبين صارخ وباكٍ، وبين متأوه وشاكٍ، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي، أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم، فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثاني: لو كانت السماوات السبع والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم، والثالث: أقبل بوجهي عليهم، أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟.
فالصادق المريد إذا خلا في ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع أجزاء نهاره، ويصير نهاره في حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار، تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير قالبه في قبة من قباب الحق مسددًا حركاته موفرة سكناته.
وقد ورد: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار». ويجوز أن يكون لمعنيين أحدهما: أن المشكاة تستنير بالمصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب يزهر بكثرة زيت العمل بالليل، فيزداد المصباح إشراقًا، وتكتسب مشكاة القالب نورًا وضياءً.
كان يقول سهل بن عبد الله: اليقين نار، والإقرار فتيلة، والعمل زيت.
وقد قال الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29].
وقال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: 35]. فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب، يزداد ضياء بزيت العمل، فتبقى زجاجة القلب كالكوكب الدري، وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب.
وأيضًا يلين القلب بنار النور، ويسري لينه إلى القالب، فيلين القالب للين القلب، فيتشابهان لوجود اللين الذي عمهما. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الزُّمر: 23]. وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين، فإذا امتلأ القلب بالنور، ولان القالب بما يسري فيه من الأنس والسرور يندرج الزمان والمكان في نور القلب، ويندرج فيه الكلم والآيات والسور، وتشرق الأرض أرض القالب بنور ربها؛ إذ يصير القلب سماءً، والقالب أرضًا، ولذة تلاوة كلام الله في محل المناجاة تسترقون الكائنات، والكلام المجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود، فلا يبقى حينئذٍ للنفس حديث، ولا يسمع الهاجس حسيس، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس، وذلك هو الفضل العظيم.
الوجه الثاني: لقوله عليه السلام: «مَنْ صلى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ». معناه: أن وجوه أموره التي يتوجه إليها تَحْسُن، وتتداركه المعونة من الله الكريم في تصاريفه، ويكون مُعانًا في مصدره ومورده، فيحسن وجه مقاصده وأفعاله، وينتظم في سلك السداد مسددًا أقواله؛ لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب.
 الرئيسة
الرئيسة